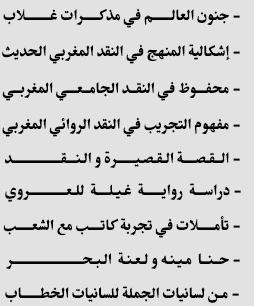قراءة في المرجعية النظرية لتجربة نزار الشعرية
د. عبد العالي بوطيب
ما من شك في أن كل كتابة أدبية، مهما اختلفت أجناسها ، إلا و تحتكم ، بشكل أو بآخر، لخلفية معرفية مرجعية ، ضمنية أو صريحة، تؤطرها و تحدد معالمها و غاياتها، لدرجة يصعب معها تصور كتابة تنطلق من فراغ ، بما فيها تلك التي يعتقد أصحابها ، لسبب أو لآخر، أنها كذلك، ما دام الجهل بالشئ لا يعني أبدا عدم وجوده ، كما هو معلوم،
صحيح أن هناك تفاوتات كبيرة بين هذه المرجعيات ، في الدرجة و الأهمية، في العمق و السطحية، حسب اهتمامات الكتاب و انشغالاتهم ، الفكرية و الفنية، لكن هذا المعيار القيمي لا ينفي ، مع ذلك ، بأي حال من الأحوال، الحقيقة الأنطولوجية القائمة.
على أنه إذا كانت مسألة حضور الخلفية المعرفية المرجعية في كل كتابة أدبية، أيا كانت طبيعتها، مسألة بديهية محسومة ، لا يختلف فيها اثنان، فإن السؤال الذي يفرض نفسه، و الحالة هذه ، يتعلق أساسا بكيفية حضور هذه الخلفية المرجعية، و مظاهر تجلياتها ، و بعبارة أخرى ، هل ينحصر ذلك في النص وحده فقط، أم يتجاوزه ليطال نصوصه الموازية أيضا ؟، وإذا كان الأمر كذلك ، وهو ما نعتقده، فما هي الخطة المنهجية المناسبة لاستخلاصها و إبراز مقوماتها ؟، وكيف ينبغي التعامل معها في قراءة النصوص و تحليلها؟ ، و أخيرا و ليس آخرا ، ما حجم قيمتها المعرفية و الإجرائية في العملية النقدية ككل ؟.
أسئلة، من بين أخرى عديدة ، تتطلب أجوبة دقيقة و محددة، و إلا ستظل هذه المسألة ، على أهميتها الكبرى ، مجرد إشكال نظري متعال، لا يمتلك قيمة فعلية على المستوى العملي.و هذا ما نسعى إليه، طبعا ، من وراء هذه الدراسة المخصصة أساسا لقراءة الخلفية النظرية لتجربة نزار قباني الشعرية.
لبلوغ هذه الغاية، كان لزاما أن نقسم الدراسة منهجيا لقسمين كبيرين ، مختلفين و متكاملين:
الأول ، خصصناه لمعالجة القضايا النظرية العامة السابقة، كما يستوجب ذلك التفكير المجرد ، بعيدا عن أي ارتباط نصي محدد، أيا كانت طبيعته و قيمته، بهدف الوصول لخلاصات معرفية عامة بخصوص مختلف الإشكالات المطروحة سابقا.
و الثاني عملي خاص عملنا فيه على اختبار القيمة المعرفية و الإجرائية لما انتهينا إليه في القسم الأول، عن طريق تطبيق خلاصاته العامة على تجربة إبداعية محددة بعينها ، لشاعر عربي الكبير هو نزار قباني. فما ذا يمكن أن يقال عن القسم الأول؟
1/ القسم النظري العام:
انتهينا سابقا لخلاصة نظرية عامة ، نعتبرها بديهية، مفادها أن كل كتابة أدبية ، كيفما كان نوعها و قيمتها ، لا يمكنها أبدا أن تنطلق من فراغ، و من ثم فلابد لها من خلفية مرجعية تدعمها و تؤطرها، حتى لو لم يكن أصحابها واعين بذلك ، ليبقى السؤال مطروحا فقط حول كيفية هذا الحضور و أشكال تجلياته.
الجواب البديهي ، طبعا، عن هذا السؤال ، هو النص ( أو النصوص)، حسب نوعية المتن المدروس، باعتباره الفضاء الأمثل لتجسيد هذه المرجعية، و التعبير عنها ضمنيا ، بشكل ملموس، من خلال تجسيد مرتكزاتها النظرية العامة كتابيا في خصائص جمالية و فكرية تميزه و توضحه ، لدرجة يستطيع معها القارئ العودة لهذه الأصول المرجعية الثاوية وراء مظهره التعبيري الخارجي ، كلما تطلب الأمر ذلك.
غير أنه إذا كان هذا النوع من الحضور الضمني للمرجعيات الفنية و الفكرية في الأعمال الأدبية عاديا و طبيعيا في كل النصوص دون استثناء، و يتطلب في الغالب مجهودا استثنائيا من القارئ للوقوف عليه، فإن هناك ، بالمقابل، أشكالا أخرى ، لا تقل عنه أهمية ، و إن اختلفت عنه كما و كيفا، و أخص بالذكر، أساسا ، تلك التي لا يكتفي أصحابها بالحضور المرجعي غير المباشر ، فيقرنونه بآخر مباشر ، يعبرون من خلاله ، بشكل صريح عن هذه الخلفية التي يضمرها النص ، كما لو كانوا لا يقتنعون بنجاعة التعبير الضمني عنها ، فيسعون جاهدين لتأكيده باسلوب صريح مباشر، غالبا ما يتخذ شكل خطاب ميتا نصي ( métatexte ) ملازم و مصاحب للخطاب النصي ( le texte ) ، يحضنه ، و يتأمله ، بشكل مرئاوي صريح ، يحاصر القارئ، و لا يترك له فرصة الاجتهاد في تحديد مقومات هذه المرجعية الإبداعية(+) .
و هنا أعتقد أني لست في حاجة للتأكيد بأن هذه التقنية الأخيرة ، خلافا للأولى ، حديثة، و لا تتطلب مجهودا كبيرا من القارئ.
و لما كان النص طبعا لا يحضر وحده، مجردا من كل مصاحبات نصية (paratextes) تحميه و تصون كيانه، خصوصا بعدما يتخذ شكل كتاب (+)، فقد عمل جل الأدباء على استغلال هذه العتبات (seuils) ، القريبة منها و البعيدة، للتعبير صراحة عن تصوراتهم و قناعاتهم ، الفنية و الفكرية، بشكل يسمح القارئ أحيانا، بتكوين فكرة شاملة و متكاملة عن الخلفية المرجعية المضمرة ، و المؤطرة ، بشكل من الأشكال ، للنص. تماما كما يحصل عادة في المقدمات و البيانات و غيرها من المناصات السابقة و اللاحقة للعمل(+)
و بذلك يتضح ، بما لا يدع مجالا للشك ، أن هناك أكثر من مكان للتعبير عن هذه المرجعيات ، و أنها تتوزع في مجموعها بين ما هو نصي داخلي ، مضمر و/أو صريح ، و ما هو خارج نصي صريح فقط، و ما على الراغب في الوقوف على تفاصيلها سوى العودة لهذه النصوص و النصوص الموازية لها، بمختلف أنواعها و مواقعها، للتأكد من ذلك، مع ملاحظة بسيطة ، لكنها هامة، تتمثل في أن جميع الإشارات الصريحة المباشرة المتعلقة بهذا الموضوع، أيا كان نوعها ، نصية كانت أم خارج نصية، ينبغي التعامل معها أثناء الدراسة و التحليل بنوع من الحيطة و الحذر، و أن لا تؤخذ مأخذ الحقائق النهائية، قبل فحصها و التأكد من صحتها على المستوى الملموس للنص ، ما دامت تعتبر ، في رأي العديد من المنظرين ، مجرد تعبير عن نوايا ، لا تكتسب قيمتها النقدية الفعلية إلا بعدما تترجم لحقائق إبداعية ملموسة مجسدة على مستوى كتابة النص المدروس(+). لتبقى الإشارات النصية الداخلية المضمرة وحدها ذات مصداقية حقيقية متعالية عن كل طعن ، و قابلة بالتالي للاستغلال و الاستثمار على مستوى الممارسة النقدية ، دونما خوف أو وجل، خلافا للإشارات المرجعية الصريحة السابقة ، على اختلاف أنواعها و مواقعها. شأنها في ذلك شأن الأفعال لا الأقوال .
قديما كان الفرق بين الأدب و النقد واضحا ، أو هذا ما كانت توحي به ، على الأقل، النظريات الكلاسيكية، لدرجة اعتبر معها الجمع بينهما ، بمختلف أشكاله ، عملا مشينا يسئ لنقاوة الألوان التعبيرية ، كما يخل بالمعايير الضرورية لكل ممارسة إبداعية.
مبدأ حاولت تجسيده مجموعة من الأقوال المأثورة في هذا الباب، يكفي أن نذكر منها بالمناسبة، على سبيل المثال لا الحصر، تعريفهم للناقد بكونه أديب فاشل.
أما الآن ، فقد بدأ هذا المبدأ يتهاوى، تاركا مكانه لتصور جديد يؤمن بتداخل الأجناس الأدبية و تفاعلها، كخطوة إيجابية أولى على طريق تطوير الأدب ، و فتح آفاق جديدة أمامه، فأصبحنا نلمس العديد من أوجه تقاطع الأدب بالنقد ، سواء في شكل حضور مقاطع ميتانصية(métatexte) في أعمال إبداعية، أو في هيمنة التعبير الإبداعي على بعض المتابعات النقدية، سلوك بقدر ما أدى لكسر الحدود بين الأجناس الأدبية ، و فتح المجال واسعا لتلاقحها، قوض في الوقت ذاته المفاهيم التقليدية المتوارثة عن الأديب و الناقد، فضاعت معايير التمييز بينهما، أو كادت ، عكس ما كان الاعتقاد سائدا من قبل.
على أن المثير في المسألة، ما أصبحنا نلاحظه ، مؤخرا من كتابات نقدية شخصية(autocritique) يهدف أصحابها من ورائها تأطير تجاربهم الإبداعية الخاصة، متجاهلين أبسط شروط الممارسة النقدية الحقيقية المبنية على الموضوعية و الحياد العلميين، بدعوى ما يعتقدونه تقصيرا من النقد و النقاد في متابعة تجاربهم الإبداعية.
على أن ما يعطي لهذه الممارسة قيمة خاصة، كونها عامة و لا تقتصر على ثقافة معينة، فضلا عن المكانة الثقافية المتميزة لممارسيها، حقيقة يكفي للوقوف عليها التذكير بأسماء بعض ممارسيها على المستوى العربي، كعبد الوهاب البياتي ، و صلاح عبد الصبور، و أدونيس ، و نزار قباني.
و هو ما يستوجب ، في اعتقادي ، القيام ببحث علمي موضوعي دقيق، يهدف الكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظاهرة، و ضبط أبعادها و مضاعفاتها ، الآنية و المستقبلية، السلبية و الإيجابية، على الحركة الإبداعية عامة، و تجارب أصحابها خاصة، بعيدا عن دائرة التبريرات الرخيصة المستهلكة.
و في انتظار توفر الشروط العلمية الضرورية لإنجاز ذلك، لا بد من الاعتراف مبدئيا، بفائدة هذه الكتابات التنظيرية الموازية، و دورها الكبير في التعريف بتجارب أصحابها، و توضيح مواقفهم الخاصة من مختلف القضايا الإبداعية المطروحة المرتبطة بها ، مما يساهم ، دون شك ، في تحسين مقروئيتها .
2/ القسم التطبيقي الخاص:
للاقتراب أكثر من هذه الآراء / الخلاصات ، و اختبار مدى صحتها ، سنقوم برحلة في كتابات شاعرنا العربي الراحل نزار قباني ، الشعرية و التنظيرية(+)، في محاولة لاستجلاء خلفيته المرجعية العامة ، و تحديد مواقفه من بعض القضايا الإبداعية الشائكة، لاقتناعنا الراسخ بأن الكثيرين استمتعوا بسحر قصائده عن طريق القراءة أو الغناء، لكن القليلين يعرفون شيئا عن هذا الجانب التنظيري المضئ في شخصيته.
أ/مفهوم نزار الخاص للكتابة الشعرية:
يصر نزار ، قبل عرض رأيه بخصوص هذه المسألة، على الدخول، أولا في حوار سجالي مع أصحاب المفاهيم التقليدية القديمة،قصد هدمها ، أولا ، و تخليص عقول القراء من سطوة تفاهتها ، بما يجعلهم مؤهلين لقبول مفهومه الجديد و تفهمه على أحسن وجه، اقتناعا منه بأن الفكر الإنساني لا يمكنه الجمع أبدا بين الشئ و نقيضه في نفس الوقت.
وهكذا يرى أن أغلب الكتب العربية، ذات الاهتمام النقدي، من ابن سلام لبداية عصر النهضة العربية الحديثة، حاولت كلها ، مع فارق في الكيفية طبعا، تعريف الشعر تارة ، بحسب عناصره المكونة: ( الشعر كلام موزون مقفى)، و تارة أخرى، بحسب طريقة تناوله للأشياء : ( الشعر تصوير للطبيعة)، تعريفان لا يصادفان هوى في نفس نزار، لأن الأول يقف عند الفروق الشكلية بين الشعر و النثر، و لا يتجاوزها لما هو أعمق ، كما لو كان النثر لا يمكن إطلاقا أن يكون شعرا، أو أن كل كلام موزون مقفى يعد بالضرورة شعرا ، يقول : ( أليس من المخجل أن يلقن المعلمون العرب، تلاميذهم في هذا العصر، عصر الذرة و مراودة القمر، مثل هذه الأكذوبة البلهاء؟، ماذا نقول للشاعر، هذا الرجل الذي يحمل بين رئتيه قلب...و يضطرب على أصابعه الجحيم، و كيف نعتذر لهذا الإنسان.. الذي تداعب أشواقه النجوم، و تفزع تنهداته الليل... كيف نعتذر له بعد أن نقول عن قصيدته ، التي حبكها من وهج شرايينه، و نسجها من ريش أهدابه،إنها كلام، و كلمة، كلام، هذه ...تقف في قلبي يابسة كالشوكة، لأن ما يدور بين الباعة، على رصيف الشارع هو كلام، و الضجة التي ترتفع في سوق البورصة هي مجموعة من الكلام، دون أن يكون ثمة فرق بين كلام ـ ممتاز ـ و كلام ـ رخيص ـ )(1).
إنه يرفض هذا التعريف ، بالقدر الذي يرفض به أن يسمى الشعر كلاما، لأنه إذا كان الأمر كذلك ، فبماذا نسمي ما يدور على ألسنتنا يوميا، أليس كلاما هو الآخر؟، و إلا فما الفرق بينه و بين الكلام الآخر ( الشعر)؟، وهل من المعقول أن ننعت خطابين مختلفين بتسمية واحدة؟، أ ليس من الإجحاف في حق الشعر أن يقال عنه إنه كلام؟,
إن تعريفا كهذا يعتبر في رأي نزار هزيلا جدا ، ما لم يوفق في العثور على معيار أعمق للتمييز بين الشعر و الكلام العادي,
نفس الموقف الرافض يتخذه نزار من التعريف الثاني المحدد للشعر في تصوير الطبيعة، لأنه يحصر مهمة الشاعر في نقل الواقع و استنساخه دون إبداع أو ابتكار، و كأنه آلة فوتوغرافية تعكس الأشياء بحيادية مطلقة دون إحساس أو تفكير: ( يقال في تعريف ثان للشعر إنه تصوير للطبيعة، و أنا أقول ، إن الفن هو ,,, الطبيعة مرة ثانية، على صورة أكمل، و نسق أروع، الطبيعة وحدها فقيرة عاجزة، مقيدة بأبدية القوانين المقدرة عليها، هذه الزهرة تنبت في شهر كذا,,, و هذا النوع من العصافير يرحل عن البيادر في أوائل الشتاء، أما في الفن ، فإنك تشم رائحة الأعشاب لمجرد تصفحك ديوان ابن زيدون، و إنك لتستطيع أن تسمع إلى وشوشة الينابيع، و أنت أمام الموقد تقرأ ما كتب البحتري و ابن المعتز)(2),
و هو ما يبعث على الاعتقاد بأن نزار يميل إلى تبني مفهوم أرسطو القائل بأن الفن صورة إبداع للواقع ، كما ينبغي أن يكون، و ليس نسخا لما هو كائن، و هو بذلك أبعد أن يكون رديفا للطبيعة، كما كان يعتقد أفلاطون، و إلا لما كانت هناك حاجة إليه إطلاقا)(+),
على أن ما يقلق نزار في التعريفين السابقين، هو ما يصبغانه على التجربة الشعرية من ضحالة، و يطبعان به الإبداع من سهولة، غالبا ما تطمع البسطاء في تعاطي الشعر، كما تفقد المبدعين، في المقابل، امتيازهم و تميزهم، و بذلك يتحول الشعر لميدان سهل ، يدخله كل من رزق عطف البحور و القوافي، و لو لم يرزق خصب التجربة ز الإبداع، مما ينزل الشعر عن مكانته السامية الحقيقية: ( تعلمت أن كل كلمة يرسمها الشاعر على ورقة، هي لافتة تحد في وجه العصر، و أن الكتابة هي إحداث خلخلة في نظام الأشياء و ترتيبها،,,,,تعلمت أن الأدب ليس نزهة نشكها في عروة سترتنا، لكنه عبء من المتاعب نحمله على أكتافنا، الأدب جزية و ضريبة ومشي مستمر على سطح من الكبريت الساخن، الأدب ليس ابن السهولة، و لا ابن المصادفة، أقول هذا لكل الذين يحسبون أن الموهبة ورقة يانصيب رابحة، تخرج من كيس، لا علاقة للأدب باليانصيب أو بالحظ،، و الشهرة ليست مائدة ,,, تهبط من السماء)(3)، لهذا فالموهبة وحدها لا تكفي كسلاح للشاعر ، لأنها لا تشكل سوى عنصر واحد من بين عناصر مختلفة أخرى، تتضافر كلها في تكوين الشاعر الحقيقي،
و بدونها يفقد الإبداع جوهره ، ليتحول لمجرد صنعة فنية، بلا طعم و لا إحساس، و هو ما يتنافى و تصور نزار الخاص للشعر، كبحث مستمر لا يعرف الملل ، أو إبحار دائم نحو المجهول بلا كلل، إن الشاعر كالبحار تماما لا يعرف الاستقرار: ( لأن أسوأ شيء في تاريخ البحار، هو الرسو في ميناء واحد، و الميناء الواحد مقبرة للطموح)(4)،
لهذا فكيفما كانت قيمة الشكل الفني الذي انتهى إليه الشاعر في رحلته الإبداعية، فإن جذوة التجوال ينبغي أن تظل مشتعلة في أعماقه، لا تموت، ما دام يتطلع باستمرار نحو الإبداع و الابتكار، لأن التوقف موت، و الشاعر من أنصار الحياة: ( عظمة الشاعر تقاس بقدرته على إحداث الدهشة، و الدهشة لا تكون بالاستسلام للنموذج الشعري العام، الذي يكتسب مع الوقت صفة القانون السرمدي,,, لكن تكون بالتمرد عليه و رفضه و تخطيه، الشعر ليس انتظار ما هو منتظر، و إنما هو انتظار ما لا ينتظر، إنه موعد مع مجيء لا يجيء، و الآتي الذي لا يأتي، الشعر الحقيقي لا يسير على الأرصفة المخصصة للمارة، و لا يتقيد بالإشارات الضوئية، و إنما يتقدم في المجهول و الحدس و المغامرة)(5),
ب/موقف نزار من التراث:
يعكس تصور نزار السابق للشعر في عمقه ، مفهومه الخاص للحداثة، و موقفه من التراث، باعتبار الحداثة، في جوهرها ، موقفا فنيا و فكريا ، يتخذه الشاعر من التراكمات الإبداعية السابقة لأمته ، و للإنسانية، انطلاقا من خصوصية المرحلة التاريخية التي يحياها، و ما دام نزار يعتبر الشعر مغامرة مستمرة لتجاوز المعلوم نحو المجهول، و رحلة دائمة لكسر نمطية القوالب التعبيرية المستهلكة، فإن موقفه من التراث، سيكون ، بالضرورة، إيجابيا متحررا ، يسعى لإغناء الموجود، و إثرائه بما يمكنه من مسايرة التطورات ، التاريخية و الفكرية ، و تجديدها,
لهذا لا نستغرب إذا ما وجدناه ينعت نفسه بكونه : ( شاعر مصاب بفقد الذاكرة)، إذا ما كانت الذاكرة تعني اجترار النماذج الإبداعية الجاهزة القابعة في التراث، دون تطوير أو إضافة، و هذا ما أعطى التجربة الشعرية الحديثة ، في اعتقاده، قوة خاصة، مكنتها من كسر مركزية الزمن الإبدعي العربي، و فتحه على آفاق مغايرة جديدة: ( إن أخطر ما فعلته القصيدة العربية الحديثة، هو الخروج عن الزمن الشعري العربي الواقف، إلى زمن تتمدد أجزاؤه، و تتسع في كل لحظة، القصيدة الحديثة جاءتنا و معها زمنها الخاص، بعد أن كان جميع الشعراء العرب يسكنون في زمن واحد، كما تسكن القبيلة في خيمة واحدة،،،لم تعد وظيفة القصيدة الحديثة أن تعلمنا ما هو معلوم، و تنظم لنا من جديد ما هو منظوم، بل صارت وظيفتها أن ترمينا على أرض الدهشة و اللاتوقع، و تسافر بنا إلى مدن الغرابة)(6)،
ج/ مفهوم نزار للالتزام في الشعر:
تأتي قضية الالتزام في طليعة القضايا التي شغلت حيزا كبيرا في كتابات نزار التنظيرية، لاعتبارات عديدة، لعل أبرزها ، كونها تشكل الصخرة التي تحطمت ،أو كادت ، على صلابتها قيتارته، من جهة، و لعلاقتها الملتبسة ، من جهة أخرى، بموضوعاته الشعرية المفضلة ( الغزل/ الحب / المرأة,,)، خصوصا و الكل يعلم أن نزار اشتهر ، و لعقود طويلة بلقب ( شاعر المرأة)إلى أن جاءت نكسة 1967، فحولته: ( من شاعر يكتب عن الحنين لشاعر يكتب بالسكين) ، فكانت قصيدته الساخنة ( هوامش على دفتر النكسة) إيذانا بموت الشاعر الولهان، وميلاد الشاعر المناضل:
أنعي لكم يا أصدقائي ، اللغة القديمة
و الكتب القديمة
أنعي لكم
كلامنا المثقوب كالأحذية القديمة
و مفردات,,الهجاء و الشتيمة
أنعي لكم
أنعي لكم
نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة
مما أثار حفيظة العديد من النقاد و المفكرين، الذين اعتبروا تحوله هذا انتهازيا غير مشروع، و أن شعره السابق في المرأة يمكن اعتباره ، بمعنى من المعاني ، عاملا من عوامل النكسة، علما بأن النكسة ليست شيئا طارئا على الواقع العربي، بقدر ما هي علامة بارزة على تدهور كان موجودا قبلها، تكفلت هي بفضحه و تعريته، لا أقل و لا أكثر، فأين كان نزار ساعتها إذن، و أين كانت نبوءته الفنية ؟
لهذه الأسباب ، و غيرها، حظيت هذه المسألة بعناية خاصة في كتابات نزار التنظيرية، فكيف عالجها؟ و كيف كان موقفه منها ؟
الواقع أن موقف نزار من هذه القضية يتفرع لنقطتين مختلفتين و متكاملتين في نفس الوقت، هما:
حرية الأديب
و نساوي الموضوعات في الشعر
فبخصوص النقطة الأولى يرى نزار أن الشاعر ، كيفما كان مستواه، لا يمكن أن يؤدي واجبه تجاه فنه و جمهوره ، إلا في ظل الحرية، و بدونها يسقط كما تسقط أوراق الخريف عند أول هبة ريح: ( فبالحرية وحدها نخرج من مرحلة ـ القيشاني ـ و نكتب على جدران العصر، و بالحرية ندخل إلى أرض الدهشة و المفاجآت، حيث الجبال تتحرك باستمرار، والأشجار تطول و تقصر على كيفها)(7),
فالشعر رديف للحرية، و الحرية أساس الإبداع الشعري، أما الضغط و القهر فقتل لملكات الإبداع لدى المبدع، و كلما حدت حرية الفنان في اختيار موضوع تعبيره، إلا و كان ذلك إيذانا بنضوب معين الإبداع في نفسه، لأن الإبداع عدو لدود للقيد، و وجود الواحد منهما علامة فارقة على غياب الآخر، و هذا ما يفسر ، في اعتقاد نزار، الفقر الفني الذي منيت به بعض قصائد الشعر العربي الحديث: ( فجيعة الشعر الأساسية، هي أنه دخل في نطاق البرمجة و مشاريع السنوات الخمس أو العشر، و تخطيطات الحزب، فأصبح يخطط له في الغرف الضيقة، كما يخطط للمزارع التعاونية، و تعبيد الطرقات، و بناء معامل الحديد و الصلب، تلك هي كارثة الشعر الذي يعيش في حالة إقامة جبرية، و يمنع من ممارسة حركته الطبيعية، و حريته و إنسانيته)(8),
في مقابل ذلك، فإن كل ربط للشعر بموضوع محدد، يعتبر تهديدا لمبدأ حرية الشاعر في اختيار الموضوع المناسب، ما دامت كل الموضوعات صالحة للشعر، في حضور الشاعر المبدع، أما في غيابه فتفقد أكبر الموضوعات هيبتها: ( إن موضوع القصيدة، مهما بلغ من القيمة، لا يشكل درعا واقية لها، و لا يحقنها بالفيتامينات الضرورية لإطالة حياتها، خذ القضية الفلسطينية مثلا، لقد كانت حقلا تجريبيا لملايين القصائد ، و لكن شرف القضية الفلسطينية لم يكن وحده كافيا لمنح من كتبوها أي وثيقة امتياز إبداعية، فعاشت القصائد الموهوبة، و ماتت الطروح الشعرية منذ لحظة ولادتها)(9),
فقيمة الشعر تقاس بدرجة إبداعيته، أما الموضوع وحده فيبقى ، على قيمته، عاجزا عن رفع القصيدة الضعيفة فنيا لمستوى الخلود، لذلك على الفنان الراغب في الحفاظ على اسمه ضمن قائمة المبدعين الحقيقيين، ألا يستجدي الجماهير باعتماد موضوعات حساسة، لأن ذلك سرعان ما يزول بزوال ظرفية تلك الموضوعات، فيطويه النسيان، و كأنه لم يكن: ( لأن الشعر حين يغدو أرفع بهذه الوسيلة، علينا أن نقول إنه يغدو أرفع من نفسه، فهو ينقص مرتبة، من حيث هو شعر، و لذلك يجب أن يوصف عن جدارة بأنه أدنى ، أي أنه يعاني نقص الشعر)(10),
و نزار بموقفه هذا ، يبدو أميل لمناصرة اتجاه الفن للفن ، في محاولته تجريد الشعر من أي وظيفة غير وظيفته الإبداعية، المتضمنة فيما يحمله من قيم جمالية، و هو ما عبر عنه صراحة في كتابه ( الشعر قنديل أخضر) قائلا: ( وضعت يدي على مفتاح المشكلة، نحن نطلب من الجميل فوق ما يحتمل، لم يعد يقنعنا طيب الزئبق، نريد أن نأكل ورقه الأبيض، إنني ضد نظام السخرة في الأدب، ذلك النظام الذي جعل ألوف القصائد العربية تمسح جباهها بأقدام الحاكم، ,, و الالتزامية الحديثة، كما نلمحها في آثار كتابها، ليست سوى شكل جديد من أشكال نظام السخرة، مع فارق واحد، هو أن المسخر كان في الماضي فردا، و أصبح اليوم نظاما اجتماعيا، أو عقيدة سياسية، أي أننا استبدلنا ديكتاتورية الفرد بديكتاتورية المجموع)(11),
لهذا فالأدب الثوري، لا يعني بالنسبة له شيئا، ما دام يختزل الأدب في شعار سياسي مجرد من كل إبداع، و يخرجه بالتالي من دائرته، ليضعه بالمقابل في دائرة أخرى مخالفة تماما لطبيعته، أما إذا أردنا ، فعلا، أن تأخذ هذه الكلمة معناها الحقيقي، فعلينا تحويلها لثورة في الأدب، يتمم بها الأديب في جانبه ما حققه السياسي في مجاله)(12),
د/ نزار و اللغة الشعرية:
الحديث عن اللغة الشعرية، حديث عن الشعر، عن طبيعته و كينونته،لما للغة من دور أساسي في تكوين الإبداع الشعري و تشكيل ملامحه، فاللغة هي الأداة و الوسيلة، و هي الغاية و الهدف في ذات الوقت، و الشاعر الذي لا يسائل لغته أثناء الكتابة( شاعر مزيف) ، لا يدرك كنه الشعر،
و حينما تطرح اللغة الشعرية للنقاش، فهي لا تطرح باعتبارها أداة للكتابة فقط، لا يمتلك الشاعر عنها بديلا، و لكن باعتبارها أيضا خطوة نحو الآخر، و أسلوبا لتحقيق التواصل معه، و هذا ما يضفي عليها أهمية خاصة، لأن تحديد طبيعة اللغة الشعرية، معناه في العمق تحديد لنوعية العلاقة التي نريد إقامتها مع أنفسنا و مع الآخرين، بكل ما يترتب عن هذا الاختيار الحاسم من مضاعفات لا تقل عنه أهمية، كتحديد الشعر و طبيعته و وظيفته،
و ككل مبدع يعنى بإنتاجه و يسائل أدواته، واجه نزار هذه الإشكالية، منذ بداية رحلته الطويلة مع الشعر، خصوصا بعدما وجد نفسه ، و هو يكتب أولى قصائده أمام لغتين : لغة الشارع، و لغة الفكر، لغة التداول ، و لغة الكتابة: ( أول ما شغل بالي حين بدأت أكتب، هو اللغة التي أكتب بها، و بالطبع كانت هناك لغة ، بل لغة عظيمة ذات إمكانيات و قدرات هائلة، لكن اللغويين فرضوا عليها احتكارا رهيبا، و أقفلوا عليها الأبواب، و منعوها من الاختلاط و الخروج إلى الشارع، إلى جانب هذه اللغة المتعجرفة، التي لم تكن تسمح لأحد أن يرفع الكلفة معها، كانت اللغة العامية في الطرف الآخر نشيطة متحركة، مشتبكة بأعصاب الناس و تفاصيل حياتهم اليومية، بين هاتين اللغتين، كانت الجسور مقطوعة تماما، لا هذه تتنازل عن كبريائها لتلك، و لا تلك تجرؤ على طرق باب الأولى و الدخول في حوار معها، من هنا كنا نشعر بغربة لغوية عجيبة، بين لغة نتكلمها في البيت، و في الشارع، و في المقهى، و لغة نكتب بها فروضنا المدرسية، و نستمع بها إلى محاضرات أساتذتنا، و نقدم بها امتحاناتنا)(13),
أمام هذه الازدواجية اللغوية، كان لزاما على الشاعر أن يتخذ موقفا معينا، فإما أن يختار لغة المعاجم و المحاضرات، فيصعد برجه العاجي ليتأمل نفسه، و لا شيء غيرها مما يحيط به، و هنا يصبح الشعر حديث النفس للنفس ، فيوصف بالتقوقع، و إما أن يختار لغة الشارع، بحيويتها ، ببساطتها، و بالتصاقها بالواقع، مضحيا بجواز عبوره القومي في سبيل مواطنة ضيقة، بكل سماتها و همومها، اختيار لا شك صعب و حاسم بالنظر لارتباطه الوثيق و المباشر بقضايا أخرى لا تقل عنه أهمية، كمفهوم نزار الخاص للشعر و دوره و مسؤوليته، لهذا كان طبيعيا أن تحظى هذه الإشكالية باهتمام استثنائي في كتابات نزار التنظيرية، ما دام الشعر عنده: ( سفر إلى الآخرين، و السفر إلى الآخرين هو مهنتي، و يوم أفقد جواز سفري ، و حقائبي المليئة بالكلمات، سأتحول إلى شجرة لا تسافر، و أموت، إنني لا أتصور شاعرا يلعب مع نفسه، إلا إذا كان لا يعرف قواعد اللعبة، أو يخاف الاختلاط ببقية أولاد الحارة، الشاعر صوت، و من أبسط خصائص الصوت أن يترك صوتا، و يصطدم بحافز إنساني، و بدون هذا الحاجز الإنساني يصبح الكلام مستحيلا، و اللغة خشخشة أوراق يابسة في غابة لا يسكنها أحد,,, إذن فالشعر، خطاب نكتبه إلى جهة ما ، و المرسل إليه عنصر هام في كل كتابة، و ليس هناك كتابة لا تخاطب أحدا، و إلا تحولت إلى جرس يقرع في العدم)(14),
إن مفهوما كهذا يدخل المتلقي كطرف اساسي في العملية الإبداعية، يفرض ، بالضرورة، الاهتمام باللغة الشعرية، باعتبارها أداة ذات حدين، قد نستعملها لربط الاتصال بالآخرين، أو لإغلاق الباب دونهم، سواء بسواء، مما يطرح تحديا صعبا على الشاعر تجاوزه قبل الشروع في الكتابة، فماذا كان موقف نزار من هذا المأزق الحرج؟
لتجاوز هذه المعضلة، و ضمان تواصل وثيق مع القارئ، اختار نزار ( لغة ثالثة) وسطا بين الفصحى و العامية، تأخذ من الأولى منطقها و رصانتها، و من الثانية حرارتها و نفاذها: ( أنا منذ أولى خطواتي الشعرية تجنبت وعاء الغراء، و تعاملت مع المفردات الموجودة على شفاه الناس، تعاملت مع الكلمة الساخنة، و الطازجة و المعجونة بلحم الناس و أعصابهم و وقائع حياتهم اليومية,,, من رحم الكلام اليومي تخرج قصائدي، و أية ولادة لا تحدث في هذا الرحم ، هي ولادة قيصرية، إني ضد الولادات القيصرية في الشعر، و مهمتي كشاعر هي أن ألتقط الشعر من أفواه الناس ، و أعيده إليهم)(15),
و بذلك ، اقتربت قصائده من لغة الحديث اليومي ، متجاوزة صرامة الخطاب القاموسي، و رصانته، مما أكسبها انتشارا جماهيريا غير مسبوق,
إذا أضفنا لذلك اقتناع نزار الراسخ بأن اللغة في ذاتها خرساء، و لا تضمر أي قيمة خاصة، و أن كل شيء يتولد فيها من خلال التركيب، و ضم الكلمات لبعضها البعض،و الشاعر الذي لا يتقن ذلك، يعجز عن فك أسرار اللغة، تماما كالمهندس، وحده يستطيع تحويل الأحجار الخام لتحف فنية: ( لأن المهم في اللغة لا كثرة المفردات، و إلا كان القاموس المحيط أكبر شاعر في الدنيا، المهم هو تركيب المعادلات المقنعة في الشعر، و معرفة كيمياء اللفظة و تركيبها، فالحجر متوافر في جميع أنحاء الدنيا، و لكن المهندسين هم الذين يعطون الحجر أشكالا ليست في الحسبان)(16),
فلا الكلمة وحدها كمفردة، و لا القاموس كتراكم لفظي ، قادران على إعطائنا شعرا جميلا، و لهذا لا تقاس قيمة القصائد بحجم كلماتها، ما دامت الكلمة تستمد جمالها من علاقتها بالكلمات الأخرى، السابقة و اللآحقة، و بدون ذلك تبقى خرساء، بلا حياة، و لو كانت تحمل في ذاتها دلالة أجمل شيء في الدنيا، فلكي تكتسب الكلمة خاصيتها الشاعرية، لابد لها من شاعر مبدع، يعرف كيف يبعث فيها الحياة، و ينزع عنها رداء النمطية البغيضة، فقيمة الشعر من قيمة الشاعر، و ما اللغة سوى مادة خام في يده، تصلح للتعبير عن الموت، كما تصلح للتعبير عن الحياة، و ترسم الجمال كما ترسم القبح، سواء بسواء، لهذا ظل نزار يؤكد دائما ، و في غير ما مناسبة، على ضرورة تفجير الشاعر للغة ، و إرغامها على الخروج من شرنقة نمطيتها المتوارثة المستهلكة، و التحليق بها في أجواء البحث عن المجهول و المدهش، كشرط للإبداع الحقيقي: ( فبدون اغتصاب لا يوجد شعر، و الاغتصاب هنا يعني تمزيق الحاجز الذي تنسجه المفردات و الأفكار و العواطف حول نفسها مع تقادم الزمن، إنه يعني إخراج الشعر من مملكة العادة و الإدمان إلى مملكة الدهشة، و عظمة الشاعر تقاس بقدرته على إحداث الدهشة، و الدهشة لا تكون بالاستسلام للنموذج الشعري العام، الذي يكتسب مع الوقت صفة القانون السرمدي، و لكن تكون بالتمرد عليه ، و رفضه و تخطيه)(17),
ح/ نزار و ظاهرة الغموض:
في هذا الإطار يندرج موقف نزار الرافض لما يعرف اليوم بظاهرة الغموض في الشعر العربي الحديث، لآثارها السلبية على التداول الجماهيري للشعر، بجعله وقفا على فئة محدودة من القراء، لا يتجاوزهم، و هو ما يتعارض و طموح نزار البعيد الرامي لجعل : ( الفن ملكا لكل الناس، كالهواء و كالماء، و كغناء العصافير، يجب ألا يحرم منها أحد)(18),
و هذا ما جعله يعتبر مختلف التبريرات المقدمة لإضفاء الشرعية على هذه الظاهرة ( الغريبة) مجرد ادعاءات كاذبة، فاقدة لكل مصداقية، خصوصا منها تلك التي ترى أن التجربة الشعرية الحديثة، تجربة جديدة، بكل المقاييس ، على الذوق العربي المتشبع حتى النخاع بالمقومات الفنية التقليدية للشعر القديم، لذلك يحتاج لوقت غير قصير لتحقيق الألفة المطلوبة مع هذه التجربة و فهمها، و بذلك يحملون الجمهور مسؤولية انقطاع التواصل الراهن، و عزوف القراء الكبير عن الاستمتاع بالشعر، رأي يرفضه نزار بشدة ، و يؤكد أن الغموض مظهر من مظاهر العجز في التعبير الفني عند هؤلاء الشعراء، و كلما توفرت الموهبة و المقدرة المطلوبتين إلا و تمكن الشاعر من التعبير بوضوح عن أعقد الموضوعات، لأن الغموض ليس خاصية ملازمة لشروط الواقع الحديث كما يدعون، بقدر ما هو في أذهان هؤلاء الشعراء فقط، لهذا ظل دائما يردد مع إزرا باوند قولته الشهيرة : ( إننا نتألم من استخدام اللغة بغية إخفاء الفكر)(19),
تلكم أهم القضايا التي تمحورت حولها كتابات نزار التنظيرية، و موقفه الخاص منها، فإلى أي حد تنسم هذه الأقوال مع الأفعال ، وبالتالي مع الإبداع ؟، و هل يعكس منجزه الشعري هذه التصورات ؟ و إلى أي حد ؟
أسئلة كثيرة تبقى معلقة إلى حين إنجاز دراسة تكميلية أخرى، تتوخى مقارنة النوايا السابقة بالأفعال، و في انتظار ذلك ، لا بد من الاعتراف ، بنضج هذه الآراء و تماسكها,
بيان الإحالات و الهوامش:
+/ أنظر على سبيل المثال ما قاله رومان ياكوبسون بهذا الخصوص في كتابه القيم (أبحث في اللسانيات العامة).
و أيضا ما قاله كريماس و كورتيس في معجمهما السيميائي الهام.
+/ أنظر على سبيل المثال كتاب :
G genette : seuils,éd :seuil ;coll :poétique, 1987
+/ أنظر بهذا الخصوص كتاب:
G genette :palimpsestes :éd :seuil :coll :poétique :1982
+/ أنظر بهذا الخصوص المقالات الواردة في مجلة:
Littérature :n :39 /1980
+/ تشمل هذه الكتابات التنظيرية الموازية ، مقدمات بعض الدواوين ، كطفولة نهد، و بعض الكتب المستقلة ، ككتابي ( الشعر قنديل أخضر) و ( قصتي مع الشعر)، بالإضافة لمختلف الاستجوابات التي أجراها معه بعض النقاد ، كالاستجواب الوارد في كتاب ( أسئلة الشعر) لمنير العكش،
1/ نزار قباني : مقدمة ديوان ، طفولة نهد ، ص: هاء،
2/ نزار قباني : مقدمة ديوان مذكور، ص: زاي،
+/ أنظر كتاب أرسطو: فن الشعر، ترجمة و تحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية، 1973،
3/ نزار قباني: قصتي مع الشعر، ص: 13،
4/ منير العكش : أسئلة الشعر في حركة الخلق و كمال الحداثة و موتها، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى، 1979،ص: 180،
5/ نزار قباني : مرجع مذكور، ص:78،
6/ نزار قباني : مرجع مذكور، ص:178،
7/ منير العكش: مرجع مذكور، ص:203،
8/ منير العكش: مرجع مذكور، ص:194،
9/ منير العكش: مرجع مذكور، ص:203،
10/ رينيه ويليك و أستن وارين : نظرية الأدب، ترجمة : محيي الدين صبحي، مراجعة: د/ حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت ، الطبعة الثانية، 1981، ص:129،
11/ نزار قباني : الشعر قنديل أخضر، منشورات المكتب التجاري، بيروت، الطبعة الأولى، 1963،ص:124،
12/ منير العكش: مرجع مذكور، ص:200،
13/ نزار قباني: قصتي مع الشعر، ص: 118،
14/ نزار قباني : مرجع مذكور ، ص: 156،
15/ منير العكش: مرجع مذكور، ص: 188،
16/ منير العكش: مرجع مذكور، ص:183،
17/نزار قباني : قصتي مع الشعر، ص:77،
18/ نزار قباني : مقدمة ديوان مذكور، ص: ميم،
19/ نزار قباني: قصتي مع الشعر، ص:77،