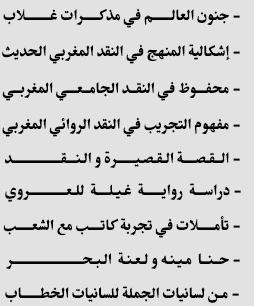مفهوم التجريب في النقد الروائي المغربي
د. عـبد العالــي بوطيب
كـليـــــة الآداب / مكناس
لا أحد يستطيع اليوم إنكار التطور الإيجابي الكبير الذي عرفه النقد الأدبي المغربي في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، بفعل تضافر عوامل عديدة ، مختلفة ومتكاملة، بعضها ذاتي وأغلبها موضوعي.
وإذا كانت العوامل الأولى محدودة ومعروفة بحكم تمحورها الكلي حول المؤهلات الفكرية والمعرفية الخاصة بالنقاد ، والجهود المثمرة التي يبذلونها في هذا المجال. فإن العوامل الثانية تبقى على موضوعيتها ملتبسة ومتشابكة، بفعل تعددها وتنوع مصادرها. وإجمالا يمكن تصنيفها لمستويين مختلفين ومتكاملين:
· المستوى الوطني الداخلي : المتمثل أساسا في المتغيرات النوعية التي طبعت مشهدنا الثقافي في المرحلة الأخيرة، وما كان لها من آثار إيجابية هامة في تفعيل الحركة الثقافية الوطنية عامة والدفع بها نحو الأمام. من ذلك مثلا:
· إنشاء الجامعة المغربية وتوسيع رقعتها لتشمل مختلف الجهات (+),
· فتح الدراسات الأدبية الجامعية العليا.
· تأسيس العديد من الجمعيات الثقافية.
· اتساع رقعة المتعلمين.
· ارتفاع أعداد البعثات الثقافية المغربية للخارج ( أوروبا على وجه التحديد).
· تكثيف نشاط حركة الترجمة.
· اتساع مجالات النشر( ملاحق ، مجلات، وكتب).
· بالإضافة طبعا للاستقرار السياسي الداخلي.مقارنة ، طبعا ،بما عرفته بعض المراكز الثقافية العربية التقليدية الأخرى ، كالقاهرة ، بيروت و بغداد ،من ظروف السياسية استثنائية خاصة(+).
عوامل تبقى على أهميتها قاصرة ما لم تؤطر بشروط ثقافية إيجابية مساعدة على المستوى الدولي الخارجي، تعد بمثابة العمق المعرفي الاستراتيجي الحاضن للمعطيات الوطنية الداخلية السابقة، والمساهم في إخصابها. وهو ما تحقق في ظل التطورات الهامة التي شهدتها الساحة الثقافية العالمية في نفس المرحلة، والمتمثلة أساسا في:
· انهيار الايديولوجيات، وتأثيره الإيجابي الكبير في تخليص الثقافة والنقد من مخالب التصورات الدوغمائية السابقة .
· التطور الهائل في مجال الدراسة اللغوية، ودوره الهام في تزويد الممارسة النقدية بمفاهيم نظرية و منهجية جديدة في قراءة النصوص الأدبية وفك بعض ألغازها.
وقد ساهم ذلك كله في تمكين الحركة النقدية المغربية من طي سلبيات المراحل السابقة، وتجاوز عثراتها. وما المؤشرات الإيجابية القوية العديدة التي يحفل بها مشهدنا النقدي الوطني حاليا إلا أدلة دامغة على ما نقول. من ذلك مثلا ما نلاحظه من ارتفاع ملحوظ في رقم الدراسات ، الجامعية وغير الجامعية، المنجزة في هذا المجال. ناهيك عما يطبع أغلبها من نضج نقدي كبير على المستويين ، النظري والتطبيقي، أدى لخفوت حدة الشعارات الإيديولوجية وسلطويتها العمياء السابقة، وتعويضها بصيغة وصفية موضوعية، تهتم أساسا بالجوانب الشكلية والدلالية للنصوص المدروسة، بدل الاقتصار على القضايا الفكرية، والسياسية منها على وجه الخصوص . مما أعاد التوازن المفقود لخطابنا النقدي بين ما هو فكري وما هو فني، بين ( سوسيولوجية المضمون) و ( سوسيولوجية الشكل)، على حد تعبير الأستاذ عبد الله العروي (*). و أهله، بالتالي ، للعب دوره الحقيقي في مقاربة النصوص الأدبية، المغربية والعربية، في ذاتها، و لذاتها، بعيدا عن كل الحسابات ، الضيقة منها والواسعة، الفردية و/أو الجماعية. وبذلك : ( شق الطرح النقدي سبيله للتخلص من إسار ملاحقة نوايا الكاتب- التي كثيرا ما افترض أنها سيئة- والبحث عنها في ثنايا تاريخه الشخصي وانتمائه الطبقي بالأساس…. ومحاولة الوصول إلى مواقف الكاتب كما تتكشف من خلال هذه الكتابة) (1).
وقد كان لذلك أثره المحمود في إعادة الثقة و الدفء المفقودين لعلاقة النقاد بالأدباء، خصوصا بعد الخراب الكبير الذي لحقها في عهود ما سمي ب ( الإرهاب النقدي) (*). وما الإجماع التلقائي الملحوظ في تصريحات أغلب المثقفين بخصوص إيجابية التحول الأخير الذي عرفه مشهدنا النقدي الوطني سوى دليل قاطع على صحة ذلك . يقول الأستاذ عبد الكريم غلاب معلقا على طبيعة هذا التطور، مقارنة بما كانت عليه الأمور سابقا: ( إن الحركة النقدية بالمغرب قد مرت بمرحلة التقبل، بما يعني أن كل ما يكتب في الخارج أو في الداخل يؤخذ على أنه مسلمات، وأن هناك وصفة عامة تؤخذ من كتاب صدر في فرنسا أو في إنجلترا أو في أمريكا، وتطبق على الإبداع المغربي وكأنها وحي يوحى، وهذا شيء طبيعي، فالقاريء عند ما يبدأ في القراءة يكون في مرحلة تقبل، وهي بمثابة وعاء يوضع فيه كل شيء، ويتم تفريغه وإسقاطه على نصوص مختلفة دون تمثل أو تمييز من طرف النقاد. أما الآن فالحركة النقدية بالمغرب تمر بمرحلة النضج ،ذلك أن النقاد أخذوا يتمثلون ما يقرأون و يستوعبونه… ويبذلون في ذلك مجهودا ذاتيا، ولم يعودوا يترجمون فقط، أو يكتفون بالنقل، في حين كانت عملية النقل والإسقاط هي التي تتحكم في إصدار الأحكام، وخلافا لذلك يبدو الآن أن الأمور بدأت تستقيم، وينبغي الاعتراف بأخطاء الماضي) (2).
الأكثر من هذا أن هناك من ذهب أبعد من ذلك ، فأقر بوجود : ( مدرسة نقدية مغربية)(+)،أو بوأ المغرب (إمارة النقد العربي)(+) . بالنظر لما حققه المغرب من سبق ملموس على باقي الدول العربية الأخرى في هذا المجال، بعد ما كان، إلى الأمس القريب، يكتفي باستهلاك ما ينتجه المشارقة (+)، عملا بالقاعدة المتداولة : ( مصر تكتب ، و لبنان يطبع، و المغرب يقرأ)، و ما العبارة الشهيرة للمؤرخ المغربي عبد الواحد المراكشي :( ما رن صوت في المشرق إلا و كان له صدى في المغرب)(+)، سوى اعتراف صريح ، يؤكد ما سبق أن قاله، ذات يوم ، الصاحب بن عباد ، وهو يقرأ : ( كتاب – العقد الفريد- لابن عبد ربه: - هذه بضاعتنا ردت إلينا-) . واقع يبدو أن الظروف تجاوزته بعد ما أصبح : ( المغرب يكتب، و لبنان يطبع، و العالم العربي ، أو بعضه على الأقل يقرأ و يكتشف و يصيخ السمع)(3).
حقيقة لا تنم بتاتا ، كما قد يتصور للوهلة الأولى، عن نزعة شوفينية ضيقة لدى المثقفين المغاربة، ما دام المشارقة أنفسهم، أو بعضهم على الأقل، ممن يمتلكون الجراة و الشجاعة الكافيتين ، يقرون بهذا التفوق أيضا. فهذا الدكتورجابر عصفور في كتابه - زمن الرواية- يصف التحول في مركزية النقد العربي من المشرق للمغرب ب :(طفرة النقد المغربي) (4). و هو نفس الرأي تقريبا الذي عبر عنه الأستاذ شوقي بغدادي في تقويمه الشامل لمواد الملف العام الذي أنجزته مجلة الآداب البيروتية عن: ( الأدب المغربي الحديث ) في منتصف العقد الأخير من القرن العشرين ، يقول فيه : ( .. إلا أن إنجاز المغاربة قي ميدان النقد الأدبي ، كما بدا لي، متقدم جدا ، بالرغم من تأثره الشديد بمدارس النقد الغربي ، و إصراره على استخدام مصطلحاتها و أساليبها، إن الدارسين أنفسهم يتمثلون ثقافتهم أعمق فأعمق، و يسدون بجدارة فجوة واسعة في بناء النقد العربي المعاصر، و لا أستغرب أن يلعب المغرب خاصة دور الطليعة الرائدة في هذا الحقل من حقول المعرفة)(5).
غير أن هذه المعطيات جميعها، على موضوعيتها ووجاهتها، ينبغي ، مع ذلك، ألا تحجب عنا بعض: (الظواهر المرضية)(+) التي ما زالت تنخر كيان ممارستنا النقدية، وتخدش صورتها ومصداقيتها. خصوصا ما يتعلق منها بإشكاليتي : المنهج و المصطلح. و لما كنا قد تعرضنا في دراستين سابقتين منشورتين ، لبعض هذه الظواهر في شموليتها(+) ، ارتأينا ، لاعتبارات موضوعية صرفة، تخصيص الورقة الحالية لظاهرة مرضية محددة و دقيقة ترتبط أساسا بكيفية توظيف الخطاب النقدي الروائي المغربي ، أو بعضه على الأصح ، لمصطلح شاع تردده ، ربما أكثر من غيره ، في مشهدنا النقدي الراهن ، يتعلق الأمر بمصطلح: ( التجريب ). في محاولة لمعرفة طريقة تعامل بعض النقاد، كي لا أقول كل النقاد ، مع هذا المصطلح ، و بأي مفهوم ، و ما ملاءمة ذلك لمقومات الخطاب النقدي المعروف ، عموما ، بخاصياته الوصفية الموضوعية ، و ما هي المخاطر المحتملة لمثل هذا التوظيف على مشهدنا الثقافي عامة ، و الروائي منه على وجه التحديد ؟.
أسئلة ، من بين أخرى عديدة ، تتوخى هذه الدراسة الإجابة عنها ، لكن قبل ذلك لا بد من إبداء بعض الملاحظات التمهيدية الأساسية المرتبطة تحديدا بالقيمة التداولية للمصطلحات ، بشكل عام ، و الشروط الواجب توفرها لقيامها بهذه المهام على الوجه الأمثل ، كخطوة ضرورية على طريق معرفة مختلف الاختلالات المحتملة التي قد تصيب طبيعتها ، و تسيء بالتالي لوظائفها التواصلية المفترضة .
فالمصطلح النقدي ، بشكل عام ، يعتبر عنصرا اساسيا من عناصر قيام نقد أدبي جاد و فعال في دراسة النصوص الأدبية و إبراز مقوماتها الفنية و الفكرية، نظرا لما يلعبه من دور حاسم في ضبط المفاهيم و توضيح الرؤى، ضمانا لموضوعية المقاربة النقدية من ناحية، و تيسيرا للتواصل الدقيق بين المهتمين و الباحثين من ناحية أخرى، خصوصا و المصطلحات ، كما يعلم الجميع ، كلمات اكتسبت في إطار تصورات نظرية محددة ، دلالات مضبوطة ، أصبحت معها محرومة من حق الانزياح المباح للكلمات العادية ، تفاديا لكل ما من شأنه التأثير سلبا على مهامها الإجرائية العلمية، و هو ما يعني ، بعبارة أخرى ، أن المصطلح النقدي علامة لغوية (signe linguistique) خاصة، تتميز عن غيرها من العلامات العادية الأخرى، بتكونها من دال و مدلول محددين مرتبطين بمجال معرفي معين، خلافا للعلامة اللغوية العادية القابلة للتدليل على معاني متعددة، ضمانا للدقة و الوضوح المطلوبين في التعبير و التلقي العلميين على حد سواء(+)، و هنا يكمن جوهر الخلاف بين اللغة الاصطلاحية و اللغة العادية، اللغة الخاصة و اللغة العامة، حيث يتم تأسيس الأولى بشكل مضاعف انطلاقا من الثانية، مما يكسبها صرامة و دقة أكثر، تتناسبان و طبيعة المهام العلمية الموكولة لها : ( فإذا كان اللفظ الأدائي في اللغة صورة للمواضعة الجماعية ، فإن المصطلح العلمي في سياق نفس النظام اللغوي يصبح مواضعة مضاعفة ، إذ يتحول إلى اصطلاح في صلب الاصطلاح، فهو إذن نظام إبلاغي مزروع في حنايا النظام التواصلي الأول، إنه بصورة تعبيرية أخرى ، علامات مشتقة من جهاز علامي أوسع منه كما و أضيق منه ذمة ، و هو لهذا شاهد على غائب ، و هي حقيقة تعلل بصفة جوهرية صعوبة الخطاب اللساني من حيث هو تعبير يتسلط فيه العامل اللغوي على ذاته ليؤدي ثمرة العقل للمادة اللغوية )(6).
و حتى يتسنى لهذه اللغة الواصفة ( métalangage ) القيام بوظائفها العلمية و العملية على الوجه الأكمل ، لا بد ، إذن، من توفرها على شرطين أساسيين ، هما : (...
· تمثيل كل مفهوم ... بمصطلح مستقل.
· و,,, عدم تمثيل المفهوم ... الواحد بأكثر من مصطلح واحد )(7).
فهل تحقق هذان الشرطان الرئيسيان في توظيفات خطابنا النقدي الروائي المغربي لمصطلح ( تجريب) ؟ ، و إلى أي حد ؟ ، و لماذا ؟.
للإجابة عن هذه الأسئلة ، لا بد، بداية ، من الاعتراف ، بأن مصطلح (التجريب) ، يعد من المصطلحات النقدية القليلة جدا التي تعرف إجماعا تداوليا من قبل النقاد المغاربة ، خلافا لما هو سائد في المشرق ، حيث عادة ما يعرف مزاحمة مصطلحات أخرى عديدة من قبيل : ( الحساسية الجديدة / الكتابة الجديدة / الكتابة الطلائعية و غيرها )(+) ، و هو ما يعني بعبارة أخرى ، أن هذا المصطلح لا يعاني ، في حقلنا النقدي الروائي الداخلي ، على الأقل، أي خلل على مستوى الدال ، ( signifiant)، و بالتالي فهو يحقق ، من هذه الناحية، كباقي المصطلحات الناجحة، إجماعا تداوليا قل نظيره ، ليبقى السؤال مطروحا بخصوص الوجه الثاني لهذه العلامة الواصفة ممثلا في المدلول ( signifié) . فهل تحظى بنفس إجماع الدال ؟ ، و هل تعكس تصريفات النقاد المغاربة ، أو بعضهم ، لهذا المصطلح في كتاباتهم النقدية اتفاقا معينا حول هذا المفهوم ؟ ، و الأكثر من هذا هل تراعي هذه التوظيفات شروط و مقومات اللغة الواصفة ، كما هو متعارف عليها في كل الخطابات ذات النزعة العلمية ؟.
للإجابة عن هذه الأسئلة و غيرها ، لابد من استعراض بعض الملاحظات العامة المتعلقة بطريقة تصريف هذا المصطلح في خطابنا النقدي ، علما بأنها قد لا تحضر بالضرورة مجتمعة في كل النقود ، لكنها تبقى، مع ذلك ، و في كل الأحوال، ملازمة ، بأشكال و درجات مختلفة طبعا ، لأغلبها ، من هذه الملاحظات :
أولا : التعامل المعياري عوض الوصفي : ذلك أن أغلب نقودنا الروائية تتعامل مع هذا المصطلح بحمولة إيجابية زائدة ، تتجاوز ما ينبغي أن يطبع كل المصطلحات العلمية من صبغة وصفية و موضوعية و محايدة ، بعيدة عن كل اعتبارات ذاتية خاصة ، لدرجة تتحول معها صفة التجريب ضمنيا لحكم قيمة إيجابي على النص المدروس ، دون فحص أو تدقيق، حتى و لو كان نموذجا سيئا للتجريب ، و بذلك تستوي فنيا كل الأعمال الروائية التجريبية في درجة واحدة ، و كأنها نص واحد ، و الحال كما هو معروف أن هذه الأعمال ليست كلها كذلك ، الأكثر من هذا أن بعض الأعمال التجريبية ، و ينبغي أن نعترف بذلك ، لا قيمة لها على الإطلاق ، و لا تستحق بالتالي أن تدرج ضمن خانة الأعمال التجريبية القيمة. تماما كما هو حاصل في مختلف الاتجاهات الإبداعية دون استثناء ، من واقعية لرومانسية ،فرمزية و غيرها ، و هو ما يجعلنا نتساءل ، هل يقوم هؤلاء النقاد بمهمتهم النقدية على الوجه الأكمل ، و بالتالي هل يكلفون أنفسهم عناء دراسة النصوص المنقودة في جزئياتها و دقائقها ، أم يكتفون بتصنيفها انطلاقا من اختيارات أصحابها و توجهاتهم الفنية، و بذلك تستوي و تتشابه عندهم كل النصوص على اختلاف تجاربها و مستوياتها في صفات مسكوكة معروفة سلفا ، و كأنها نص واحد , الأكثر من هذا أن ممارسة نقدية من هذا القبيل تجعلنا كذلك نتساءل ، بكل مشروعية ، مع جي دو موباسان ( Guy de Maupassant )عن حق الناقد في التعبير عن ميولاته الجمالية الخاصة ، و إلى أي حد يجوز له إخضاع النصوص المنقودة لهذه الميولات ؟ (+)، ثم ألا يوقعه ذلك في آفة المراهنة القبلية على قيمة أعمال روائية على حساب أخرى ، قد تكون أجود منها ، غير أنها ليست بالضرورة تجريبية . ألا يعد ذلك إقصاء و عنفا نقديا ضد باقي التجارب الأخرى ، التي من شأن حضورها إضفاء ثراء نوعي خاص ، مطلوب و مرغوب ، في مشهدنا الروائي المغربي ، ينقده من مخالب نمطية بغيضة ، أيا كانت طبيعتها ، من شأنها إعادتنا لعهود الجادانوفية السوفياتية المقيتة ، وآثارها السلبية المدمرة (+). و لنا في مخلفات مرحلة :( الإرهاب النقدي المغربي) أكبر دليل على ذلك(+) .
و هو ما يوحي مبدئيا بأننا استبدلنا ظاهريا خطابا نقديا شكلانيا ، بخطاب نقدي مادي ، دون أن نتمكن في العمق من تغيير جوهر الممارسة النقدية الحقيقية، المفروض قيامها على الدقة و الموضوعية ، عوض الانحياز الأعمى المسبق لاتجاهات فنية و نصوص معينة ، أيا كانت طبيعتها ، على حساب أخرى، يفترض أن يعود معيار الفصل بينها ، أولا و أخيرا ، للمقومات الفنية و الفكرية الخاصة لا غير(+) . و هو ما لا يحصل، للأسف الشديد ، في بعض نقودنا الروائية المشحونة غالبا حد التخمة بأحكام معيارية إيجابية جاهزة و غير مؤسسة على معطيات نصية دقيقة و ملموسة ، لدرجة تتجاوز معها أحيانا كثيرة حدة حماسها و تشيعها بعض ما يكتبه الروائيون التجريبيون أنفسهم، مما يجعلنا نعتقد أنهم أصبحوا ، من خلال ذلك طبعا ، أكثر تجريبية من التجريبيين. فهل يعقل هذا في خطاب نقدي يفترض فيه أساسا الموضوعية و الحياد ، و توظيف المصطلحات في بعدها الوصفي الصرف بعيدا عن كل معطى معياري مشين . و كيف سيحافظ هذا الخطاب على قيمته و مصداقيته و احترامه و سلطته الرمزية المفترضة ، بمواقفه الذاتية الظالمة السابقة ، و كيف سيكون وقع ذلك على نفسية الروائي ، هذا القارئ الناقص لأعماله: ( المتألم لعدم كفايته ، الراغب كثيرا في العثور على قارئ يكمله ، و لو كان قارئا مجهولا )( 9)، و هل بمثل هذا النقد سيتمكن صوته من الصمود و المواصلة العطاء؟.
ثانيا : التجريب ضد الواقعية : الملاحظة الثانية التي تلفت انتباه القارئ لبعض نقودنا المواكبة لنصوص روائية تجريبية ، تتمثل في تمييزها القاطع و الخاطئ ، في نفس الوقت ، بين هذه الأعمال و الأعمال الواقعية ، مما يوحي بأن هناك قطيعة نهائية بينهما ، و بأن الكتابة الروائية التجريبية غير واقعية ، أو أن الكتابة الروائية الواقعية لا يمكن أن تكون أبدا تجريبية ، و هو رأي مرفوض تماما ، كما هو معروف ، بإجماع الروائيين التجريبيين أنفسهم ، عربا كانوا أو غربيين ، ماداموا كلهم لا يقبلون بغير هذه الصفة ( الواقعية) ، و إن كانوا طبعا يختلفون في تحديد مفهومها ، و هنا تندرج في تقديري ،مآخذ التجريبيين المعروفة على الفهم التبسيطي المتجاوز القديم للواقعية ، من قبيل :
· الواقعية الإنعكاسية.
· الفصل القسري بين الشكل و المضمون.
· و إهمال الشكل في العملية الإبداعية(+).
و تأكيدهم الراسخ ، في الوقت ذاته ،على تاريخية و واقعية هذه الدعوة ، لنستمع لرأي أحدهم في الموضوع : ( نحن نريد أن تقودنا تأملاتنا ، في النهاية ، نحو شيء أكبر مما هو مطروح في سوق الرواية العربية، و ينبغي أن لا يفهم ، في أي لحظة ، بأنه دعوى للانفصال عن الشرط الاجتماعي التاريخي ، أو دعوى شكلانية محض، و لكن القضية تكمن دائما ، في استيعاب هذا الشرط ، تعميق جذوره ، و نشر ظلاله ، إنما في دائرة الرؤية الإبداعية، الرؤية الخلاقة، التي تكشف لنا أو تتيح للنص الروائي أن يتوفر على روائيته، و ليس فقط على صورة ما للواقع و للشخوص المتحركة فيه بأزمانها و مختلف أوضاعها)(10).
و هو نفس الرأي تقريبا الذي عبر عنه قبل ذلك روائي تجريبي غربي قائلا : (إن الابتكار الشكلي في الرواية ، بعيد كل البعد عن مناقضة الواقعية، كما يتخيل ذلك ناقصو النظر ، و هو الشرط الذي لا غنى عنه لمزيد من الواقعية)( 11). لذلك كله أعتقد ، جازما ، أن من الخطأ الجسيم اعتبار الأعمال الروائية التجريبية غير واقعية ، و أن الواقعية شيء آخر لا علاقة له بما يكتبه التجريبيون ، و الحال عكس ذلك تماما كما بينا ذلك سلفا ، صحيح أن الرواية الواقعية ليست بالضرورة تجريبية، لكن العكس دائما صحيح (+).
ثالثا : التعامل الفضفاض و غير الدقيق مع هذا المفهوم : نعلم جميعا أن التجريب مصطلح نقدي يعني ، من بين ما يعنيه، سعي الروائي الدائب و المتواصل لإيجاد شكل روائي جديد، مناسب لخصوصية موضوعه و مرحلته التاريخية على حد سواء ، و هو بهذا المعنى ، كما وصفه بحق أحد النقاد : ( خطاب المحتمل ، دائما، و لكنه الخطاب المستحيل ، أيضا ، ما دام الوصول إلى ذراه يستدعي تجاوزه باستمرار، والانطلاق مجددا نحو ذرى أخرى ، و بمتطلبات نصية جديدة ، و باستيعاب شمولي دائب التطور للعالم و المصائر)( 12). لذلك يصعب ، إن لم نقل يستحيل ، العثور على نصوص روائية تجريبية متشابهة ، ما دام كل روائي يتخذ له مسارا معينا في بحثه المتواصل عن شكل مناسب لتجربته و موضوعه ، و ما دامت سبل هذا البحث تبقى رغم ذلك عديدة و متنوعة حسب مؤهلات و قناعات كل روائي، في علاقتها بالمقومات التعبيرية المرنة للكتابة الروائية ذاتها ، مما يمكن الجزم معه، دون مخاطرة ، بأن الروايات التجريبية لا توحدها في النهاية سوى هذه الصفة ، أما فيما عدا ذلك ، فالمفروض أن كل تجربة روائية ، كي لا نقول كل نص روائي ، إلا و يتصف بمقومات فنية خاصة ، تماما كما عبر عن ذلك أحد الروائيين قائلا : ( بإمكاننا ، أن نزعم ، أن لكل نص روائي شكله الخاص ، إذ ليس هناك تصور نمطي للشكل منفصلا عن مضمونه)(13)، و عليه فأعمال المديني الروائية يفترض بالضرورة أنها غير أعمال التازي ، و أعمال برادة غير أعمال شغموم أ و حميش ..إلخ. كما أن ( وردة للوقت المغربي ) هي غير ( رجال ظهر المهراز) و ( رحيل البحر ) غير ( امرأة من ماء)، و ( الأبله و المنسية و ياسمين ) غير ( فارة المسك ) ، و ( لعبة النسيان ) غير ( امرأة النسيان ) و (مجنون الحكم ) غير ( سماسرة السراب) إلخ، رغم ما قد يبدو بينها أحيانا من تقارب خادع ، يوحي ظاهريا بالتشابه ، لا يصل أبدا حد التطابق . ما دامت الفروق الدقيقة تبقى ، مع ذلك ، قائمة و موجودة، و لو بشكل خافت طبعا ، و إلا كيف نبرر مواصلة كاتب تجريبي إنتاج نصوص روائية مشابهة لنصوص سابقة له أو لزملائه، ألا يعد ذلك ضربا من العبث المرفوض.
لكن إذا كان الأمر كذلك ، فيما أزعم ، فكيف يعقل أن يتعامل نقدنا مع هذه التجارب و النصوص ، المفروض بحكم طبيعتها أنها مختلفة، كما لو كانت متشابهة ، لا من حيث الخصائص الفنية فقط ، حيث يصبح تكسير خطية السرد ، و تعدد اللغات و تنوع الرؤى، و حضور الميتا سرد و التعالق النصي و التناص ..إلخ ، سمات عامة مشتركة بينها جميعا ، و لا من حيث القيمة الفنية و الجمالية ، حيث تستوي جميعها من هذه الناحية ، مما يجعلنا نعتقد ، خطأ طبعا ، أن التجريب أسلوب واحد ، و أنه أكثر من ذلك ناجح دائما رغم اختلاف التجارب و النصوص . و الحال أن الواقع عكس ذلك تماما ، و أن الذي يصورها كذلك هو الخطاب النقدي المواكب فقط ،لاعتماده التجريب قيمة متعالية واحدة و موحدة لكل هذه النصوص، دون أن يكلف نفسه عناء البحث النقدي الدقيق في خصوصية هذه الأعمال ، بعيدا عن التصورات القبلية الجاهزة ، و مغالطاتها الممكنة. لدرجة يمكن القول معها إن هذه النقود بتعاملها الفضفاض و العام مع هذه الأعمال الروائية التجريبية ، أصبحت بدورها متشابهة تكرر في مجموعها أحكاما جاهزة و أوصافا عامة مسكوكة ، غالبا ما لا يكون لها رصيد وصفي موضوعي على المستوى المحايث للنص ، و بذلك يفقد هذا النقد كل مواصفاته الحقيقية ، و يفقد معها بالتالي كل مصداقية و احترام ، خلافا لما ينبغي أن يكون عليه .
لهذه الملاحظات و غيرها نعتقد ، و نرجو أن نكون مخطئين في ذلك، أن خطابنا النقدي الروائي ، رغم المكاسب العديدة التي حققها ، ما زالت أمامه رهانات كثيرة ينبغي تداركها ، و في مقدمتها وضع حدود دقيقة و صارمة بين الكتابة النقدية و الكتابة الأدبية ، كي لا نستمر في ممارسة العملية النقدية بأساليب أدبية ، كما هو حاصل الآن ، حيث الذاتية تطغى على الموضوعية، و الانحياز يهيمن على الحياد ، و العمومية تحل محل الدقة ، لدرجة يصعب علينا التمييز بين الكتابة الواصفة و الكتابة الموصوفة ، بين النقد و الأدب ، و أعتقد أن ذلك يمر أولا و أخيرا بالاحتكام المطلق للنصوص ، اعتمادا على مصطلحات و مناهج دقيقة و ملائمة ، و فيما عدا ذلك، أعتقد أننا سنظل نكرر نفس الأخطاء السابقة ، و لن نتجاوزها أبدا.
الهوامش والإحالات:
+) ارتفع عدد الجامعات المغربية في العقدين الأخيرين إلى أكثر من أربع عشرة جامعة، بعدما كان في السابق لا يتجاوز واحدة,
+) نشير هنا تحديدا إلى القاهرة ما بعد اتفاقية كامب ديفد ، و بيروت ما بعد الحرب الأهلية، و بغداد ما بعد حرب الخليج,
*/ عبد الله العروي: الايديولوجية العربية المعاصرة، ترجمة : محمد عيتاني، دار الحقيقة للطباعة و النشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1970، الصفحة: 268/269.
1/ فاطمة الزهراء أزرويل: مفاهيم نقد الرواية بالمغرب، نشر الفنك، الطبعة الأولى: 1989، الصفحة:121.
*/ عبد الكريم غلاب: الرواية حياة متكاملة، وهي تجتاز بالمغرب أزمة نمو. مجلة آفاق، عدد:3/4، سنة:1984، الصفحة:107.
2/ عبد الكريم غلاب: حوار في الكتابة والتغيير و الهوية، مجلة آفاق، عدد:2، سنة: 1991، الصفحة:159.
+) أنظر أحمد المديني : عن مستقبل النقد الأدبي بالمغرب ، ضمن كتاب جماعي بعنوان : النقد الأدبي بالمغرب ، مسارات و تحولات ، منشورات رابطة أدباء المغرب، 2002، ص:12,
أنظر نجيب العوفي : ظواهر نصية ، منشورات عيون المقالات ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، 1992,
+) يمكن تلمس مظاهر هذا التحول النقدي الإيجابي بالمغرب في الجوانب التالية:
-
كثرة الدراسات المنجزة في هذا المجال و جودتها النقدية العالية,
-
الحضور الكثيف و الوازن للنقاد المغاربة في مختلف الملتقيات الثقافية العربية,
-
الهيمنة شبه المطلقة للنقاد المغاربة على معظم الجوائز العربية المخصصة لهذا المجال ,
-
الاعتماد الملحوظ للباحثين العرب على المراجع النقدية المغربية,
+) أنظر عبد الواحد المراكشي : المعجب في أخبار المغرب،
3/ نجيب العوفي: مرجع مذكور، 1992، الصفحة:133.
4/ جابر عصفور: زمن الرواية، منشورات المدى للثقافة و النشر، الطبعة الأولى، 1999، الصفحة:281.
5) شوقي بغدادي : مجلة الآداب البيروتية، عدد: ¾، سنة : 1995، ص: 130,
+) أنظر نجيب العوفي : مرجع مذكور ، 1992,
+) أنظر الدوريات التالية:
-
عبد العالي بوطيب : المصطلح في النقد الروائي العربي / المستويات و الترجمة المغلوطة، مجلة كتابات معاصرة، عدد: 67، سنة : 2008,
-
عبد العالي بوطيب : إشكالية المنهج في النقد العربي الحديث، مجلة فصول المصرية، عدد: 60 ، سنة : 2002,
+) لهذا فلا غرابة إذا ما وجدنا العلماء العرب يعتبرونها من هذه الناحية مفاتيح علوم,
6) عبد السلام المسدي : قاموس اللسانيات ، الدار العربية، 1984، ص: 13,
7)أحمد محمد ويس : الانزياح و تعدد المصطلح ، عالم الفكر ، عدد: 3، سنة: 1997، ص: 57,
+) أنظر بهذا الخصوص كتاب الدكتور شكري عزيز الماضي: أنماط الرواية العربية الجديدة ، سلسلة عالم المعرفة، عدد: 355، سبتمبر 2008، ص: 14,
+) أنظر ما سبق أن أثاره الكاتب جي دو موباسان في مقدمة روايته ( pierre et jean),
كتاب الجيب، رقم : 2402, أو في ترجمتنا لها في العدد : 10 ، ديسمبر 1999 ، من دورية نوافذ ، السعودية,
+) يقول أحمد المديني واصفا آثار الإرهاب النقدي الواقعي و انعكاساته السلبية في تنميط الكتابة الروائية العربية: ( و إنه ليخيل إلى القارئ ، أحيانا، أن عشرات الروايات العربية كتبت بالواقعية تلك ، تحت إرهاب نظري و خطابي مسطح ، و وراء منظورات إيديولوجية دوغمائية في فهمها للأدب ، كما هو الشأن في فهمها للسياسة)، مجلة الطرق، عدد خاص عن الرواية العربية ، رقم : ¾، سنة:1981، ص: 76,
8) أحمد المديني : مقال مذكور ، ضمن كتاب مذكور، 2002، ص: 11/12,
9) ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة ، سلسلة زدني علما ، لبنان ، ص: 13,
+) أنظر ما قاله أحمد المديني في هذا الصدد بمجلة الطريق ، عدد مذكور ، ص: 76/77,
10) أحمد المديني : مقال مذكور بمجلة الطريق، عدد مذكور ، ص: 79,
11) ميشال بوتور: مرجع مذكور ، ص: 8,
+) للمزيد من التوضيح يمكن العودة لكتاب الدكتور شكري عزيز الماضي، مرجع مذكور ، سلسلة عالم المعرفة ، عدد: 355، سبتمبر 2008، ص: 12,
12) أحمد المديني : مقال مذكور ، بمجلة الطريق، عدد مذكور ، ص: 79.
13) محمد عز الدين التازي : مقال بمجلة الطريق، عدد مذكور ، ص: 273,