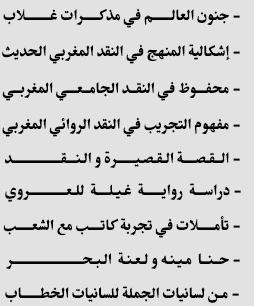بيروت في الرواية الـمغربية
د. عبد العالي بوطيب
كنت أعتقد ، لوقت قريب جدا، أن الحديث عن الامتدادات الحكائية للنصوص الروائية المغربية المكتوبة بالعربية، خارج حدود انشغالاتها الوطنية الضيقة، الخاصة منها و العامة، مسألة عادية، إن لم نقل بسيطة ، خصوصا حين يتعلق الأمر بعاصمة عربية، بمواصفات عالمية،ك(بيروت) ، تربطنا و إياها أواصر اللغة والتاريخ و الدين ,,,الخ،
غير أن هذا الاعتقاد سرعان ما تغير ، بعد قبولي الدعوة الكريمة التي وجهها لي الإخوة الأساتذة في الجامعة اللبنانية( الفرع الأول) برئاسة الدكتور سامي سويدان، للمشاركة في ندوة : ( بيروت في الرواية ، الرواية في بيروت)، و شروعي في إعداد الدراسة المقترحة لهذه المشاركة: ( بيروت في الرواية المغربية)، فإذا بي أفاجأ بخلو المنجز المغربي تقريبا من نصوص روائية تنفتح على قضايا و انشغالات هذا البلد العربي الشقيق ، ذي العمق التاريخي و الحضاري العريق، باستثناء نص يتيم جميل للأستاذ أحمد المديني بعنوان : (المخدوعون (+).
صحيح أن هناك نصوصا سردية مغربية، روائية وغير روائية، عديدة انفتحت حكائيا على هموم أقطار و عواصم ، عربية و غربية كثيرة (+)، لكنها ظلت ، رغم ذلك ، مقصرة في حق بيروت،حقيقة مفاجئة ، لم أجد لها تبريرا موضوعيا معقولا خارج العوامل الثلاثة التالية:
الأول: يتعلق ، في ما أعتقد ، بقصر عمر الرواية المغربية ، و محدودية تجاربها، كميا على الأقل، مقارنة بتجارب دول عربية أخرى سبقتنا لهذا المجال، كتجربتي مصر و الشام على وجه التحديد، لذلك لم يكن ممكنا مطالبة تجربة فتية بهذه المواصفات التاريخية المحدودة ، تجاوز شرطها الذاتي الخاص ، و إعطاء أكثر مما تسمح به إمكانياتها البسيطة ، المنهكة أصلا بقضايانا المحلية الداخلية (+)،
الثاني : يرتبط بطبيعة التجربة الإبداعية الخاصة بكل روائي مغربي على حدة ، في ارتباطها الوثيق بمكوناتها الثقافية و الاجتماعية الخاصة، بحيث يصعب مطالبة الروائي بتجاوز شروطه الشخصية، و الكتابة خارج ما هو منذور له، إلا إذا أردنا أن نجعل منه مبدعا آخر ، يتنكر لذاته و معارفه، و هو ما لا يستطيعه طبعا، لأن الروائي ، أي روائي ، لا يكتب في نهاية المطاف سوى عن ذاته ، بشكل من الأشكال ، و بالتالي عن معارفه، و هذا ما يطبع أعماله بسمات ، فنية و فكرية ، خاصة ، تميز تجربته عن تجارب باقي الروائيين الآخرين، مما يغني الساحة الإبداعية ، ويضفي عليها طابعا إيجابيا من الثراء و التنوع، و لعل هذا ما يفسر أيضا إلحاح النقاد الدائم و العادل طبعا على حصر مجال انتقادهم للأدباء عموما في ما يكتبونه وينشرونه فقط ، و لا شيء غير ذلك (+) ،
أما الثالث و الأخير: فيرتبط أساسا بمدينة بيروت ذاتها، هذه العاصمة العربية الجذابة ، ذات الموقع الاستراتيجي الحساس على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط،
و الإشعاع الحضاري و السياحي الكبير، هذه العاصمة ظلت ، رغم هذا كله ، و ربما بفعل ذلك، بالنسبة لكثير من المغاربة ، مجرد برميل رصاص قابل للانفجار في كل لحظة ، بفعل عوامل جيو سياسية خاصة بالمنطقة ، أما بالنسبة للأقلية الباقية، فهي بالإضافة لذلك، عاصمة ثقافية متميزة، بحكم توفرها على أهم دور النشر العربية(+) ،
لهذه الأسباب إذن و غيرها ، لم تكن هذه العاصمة العربية ، ذات الإشعاع العالمي القوي ، في يوم من الأيام ، مصدر جاذبية خاصة بالنسبة لغالبية الروائيين المغاربة، كما هو الحال مثلا بالنسبة لعواصم عربية و غربية أخرى ، كالقاهرة ، دمشق ، باريس، مدريد، فلسطين و غيرها ،إلا أنه إذا كان الاتجاه العام لانفتاح المتخيل الحكائي للرواية المغربية ، محصورا و محدودا ، لاعتبارات خاصة ، في العواصم المذكورة، فإن الروائي أحمد المديني ، و على عادته المألوفة دائما في التحليق خارج السرب ، سيخرق هذه الحدود ، و يتجاوزها ليحلق عاليا في سماء بيروت ، محققا بذلك نقلة نوعية هامة في سجل تجربته الإبداعية الخاصة، و سبقا حكائيا فريدا في تاريخ المشهد الروائي المغربي عامة، فما سر هذا الانفتاح المنفرد ؟ و لماذا بيروت بالذات؟ و كيف تحضر في هذه الرواية المغربية؟
و ما الأبعاد الفنية و الفكرية لهذا الحضور؟و قبل هذا و ذاك ما أهمية ذلك في التجربة الروائية الخاصة بصاحبها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة و غيرها، لا بد طبعا من العودة أولا و أخيرا للنص الروائي المذكور لتحليله و تحديد سياق إنتاجه في إطار تجربة المديني خاصة و التجربة الروائية المغربية عامة، و هكذا و بعودتنا لرواية ( المخدوعون)، العمل العاشر في تجربة المديني الإبداعية(+) ، الغزيرة و المتنوعة (+)، نلاحظ ، شكليا ، أنها تتألف من حوالي (250) صفحة من القطع المتوسط ، موزعة، بنوع من التساوي، على خمسة فصول مرقمة، بمعدل (50 ) صفحة لكل فصل، تحكي ، في مجموعها ، بانتقائية معبرة، و تفصيل دقيق، مرارة واقع مجموعة من الشخصيات ، مغربية وعربية، نسائية و ذكورية، طوحت بها ظروف مرحلة تاريخية عاتية عاصفة، في فضاء العاصمة الفرنسية باريس ، للاحتماء به من بطش الصراعات السياسية الدموية الدائرة في أوطانها الأصلية، في هذه الأجواء الخانقة المشحونة، و فوق أرض هذه العاصمة الأوروبية المتفتحة، ستحاول هذه الشخصيات الروائية، كل حسب طبيعتها و استعداداتها ، إقامة علاقة ( علاقات) عاطفية تعوضها بعضا من قساوة غربتها الإجبارية في بلد المهجر، بعيدا عن ألفة الأهل والأحباب و الوطن، علاقات ستكشف الأيام و التطورات الحكائية المتلاحقة، بشاعة وجهها الزائف، وما تخفيه من انتهازية بغيضة و استغلال مقيت، عبرت عنه الرواية ، صراحة وبشكل مباشر ، غير ما مرة ، في عدة مناسبات ، و على مختلف المستويات ، الحكائية منها و السردية، بدءا من العنوان ( المخدوعون)، و الإهداء : ( إلى من أحببتهم ، و أحبوني ، خدعتهم و خدعوني ، في سنوات باريس العاصفة، و إلى روح محمد باهي)(1)، و انتهاء باختيار نص مقدس معبر للسيد المسيح بعنوان : (العشاء الأخير)(+) خاتمة للرواية ، بكل ما يحمله من طابع جنائزي بليغ، ينعي الصداقة والأصدقاء : ( و لما آن المساء جاء الإثني عشرة، و فيما هم متكئون يأكلون ، قال يسوع: الحق أقول لكم ، إن واحدا منكم يسلمني، الآكل معي، فابتدأوا يحزنون ، ويقولون له ، واحدا فواحدا، هل أنا، و آخر هل أنا، فأجاب و قال لهم: هو واحد من الإثني عشر، الذي يغمس معي في الصفحة، إن ابن الإنسان ماض، كما هو مكتوب عنه، و الويل لذلك الرجل الذي يسلم ابن الإنسان ، كان خير لذلك الرجل لو لم يولد)(2(.
مرورا بما بينهما من مظاهر الخداع العديدة التي تحفل بها الرواية ، لدرجة تصعب معها الإحاطة بها جميعها ، بحكم خصوصية المناسبة و ضيقها، لكن هذا مع ذلك لا يمنع من الإشارة لأبرزها، يتعلق الأمر أساسا بعلاقة الحب المتين الذي جمع صدفة، بمناسبة مناقشة أطروحة جامعية بالسوربون، الطالب اليساري المغربي غانم، بالطالبة الباحثة اللبنانية، ذات الميول اليسارية، المعروفة بهاء و المسماة تارة هناء وأخرى هادية، قبل أن تتطور ، بسرعة فائقة، انتهت بمغادرة هاء لشقتها، واستقرارها نهائيا بشقة غانم، التي أصبحت ، منذ تلك اللحظة، شقتهما، كما كانت تقول(3)، ليعيشا بعد ذلك أجمل قصة حب جاد بها منفاهما الباريسي البارد: ( كانت حين تنظر في عينيه ، و ينظر في عينيها ، و قد عادا معا ، كل من جامعته، يحسبان أن المساء يناديهما، لكل مساء نداء، و لون و طعم و نار، و هما من يصنع هذه العناصر، لم يقل أحدهما للآخر أي معنى مسبق، و إن تفاهما سرا و إضمارا على قرارهما بأن يصنعا باريس ـ كما لم توجد من قبل، و يرسما لها شوارع و عناوين وأرقاما، يسيران فيها على هدى من قلبيهما ، لا يعبآن بأحد ، و تحديدا بالأجانب، ومنهم العرب المبعثرون أشتاتا ، يمشون و يختفون ، كأنما شرطة حكامهم تطاردهم حتى في هذه الربوع)(4)، وطبعا لم تكن هذه العلاقة ، كغيرها ، قائمة على العاطفة و الجنس فقط،و إنما كانت مدعومة أيضا ، فيما يبدو، ظاهريا على الأقل، بتوافق في الأفكار و المعتقدات، جعلت كل واحد منهما يجد نصفه الثاني في الآخر، رغم اختلافات الجنس و الجنسية، و ما انخراطهما القوي المشترك في العديد من الأنشطة الثقافية و السياسية سوى دليل قاطع على ذلك، غير أن هذا المظهر القوي المتين لهذه العلاقة العاطفية المثيرة لغيرة جميع الأصدقاء، و التي كان الكل يراهن على نجاحها و استمرارها ، سرعان ما انهار فجأة ، و بشكل مدو ، دون مقدمات ، بمجرد ما أنهى غانم مشواره الدراسي الجامعي ، بحصوله على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، وقراره العودة للمغرب، و ليسقط معه ، في الوقت ذاته، قناع التوجهات السياسية اليسارية المناهضة للإقصاء، و المدافعة عن حقوق الضعفاء و المهمشين ، الذي كان يخفي وراءه غانم ( الزعيم)(+) ، طوال مدة دراسته، حقيقته الانتهازية البشعة، لا في علاقته بحبيبته اللبنانية فحسب ، و إنما في جميع علاقاته الباريسية دون استثناء، لا لشيء سوى رغبته المذلة في الحصول على منصب سام ، بعيد كل البعد عن تخصصه و مبادئه، بالمخابرات المغربية، كما أخبر بذلك باهي صديقه عبد الغني، بعد أن أعياه البحث عنه في المغرب، يقول : ( صاحبك ذاك ، لعله درس الفلسفة لعلاقتها بالفلس، حين تستقر ستكتشف أن هذا ما يلهث وراءه الفلاسفة هنا قبل الفكر، لقد وظفوه في هيئة جديدة تحمل اسم ( رعاية النفوس المغربية)، و أنت لا تستطيع مقابلته ، لأن من شروط العمل في هذه المؤسسة الخفاء، فلا تبحث عنه، اللهم إن أردت العثور على الميتا فيزيقا)(5)، و بذلك تكشف الرواية ، من خلال سلوك شخصية غانم ، و الاسم له أكثر من دلالة، عن الوجه الحقيقي البشع للعلاقات الإنسانية الملغومة القائمة بين أفراد جيل ما بعد الاستقلال، أو ما أصبح يعرف بجيل القنطرة، بما له و ما عليه.
غير أنه إذا كانت هذه هي الغاية الدلالية المركزية للرواية ، كما تؤكد ذلك القرائن النصية و النصية الموازية، الحكائية و السردية، الصريحة و الضمنية، كما أسلفت، فإن هذا ، مع ذلك ، لا يمنع من إيجاد غايات تعبيرية أخرى ، لا تقل أهمية عن الأولى، خصوصا في عمل روائي قوي، على درجة كبيرة من الثراء و الإيحاء، يكفي أن نقف ، بهذه المناسبة، على واحدة منها ، نعتقد أن لها ارتباطا وثيقا بموضوع هذه الندوة و مكان انعقادها، و إن كان يحضر في الرواية بشكل خافت أقل بروزا من سابقه، عن طريق استرجاع لحظات حكائية ماضية ، بعيدة أو قريبة، خارجة عن حاضر زمن الحكاية و فضائها باريس، غالبا ما كان يقوم به السارد الرئيسي عبد الغني ، أو من ينوب عنه ( غانم أو هاء أو غيرهما)، حسب طبيعة المادة الحكائية المسترجعة، و خصوصية التقنية السردية المستعملة في استحضارها، و التي من خلالها ، يتعرف المسرود له ، و عبره القارئ طبعا، على ماضي مختلف هذه الشخصيات / الحكايات (+)، الرئيسية منها على وجه التحديد ، و حيثيات هجرتها الاضطرارية من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب.
وهكذا سنقف مع هاء مثلا، في مقاطع سردية استذكارية قوية و مؤثرة ، على بشاعة الحرب الأهلية اللبنانية لسنة(1975) و ما بعدها ، و آثارها السلبية المدمرة على البلاد و العباد، من أبسطها اضطرار هاء لمغادرة أهلها و وطنها قسرا، و الهروب بما تبقى منها، و هو قليل جدا ، لباريس : ( حين انفجر بلدها ، أو ما كان اسمه وطنا، و شرع بنوه يأكلون بعضهم ، تقول : حملت حالي و جيت عباريس، و تبرر بدون أن يسألها أحد لماذا: لأني سمعتهم دائما يقولون إن باريس مربط خيلنا)(6)، و تضيف قائلة: ( هناك في الوطن المنفجر، في بيروت، التي تتكوم تحت انهياراتها ، لا مساحة لشيء، الطرقات و الأفاريز استحالت خنادق، و هي لا تستطيع أن تسيج انهيار الأمس ، أو تغطي ثقوبه الهائلة بعمران اليوم، العمران الإسمنتي ، أنى له أن يشيد أرواحا جديدة، الأجمل و الأرحب قبالتها، لا في الخلف، حيث تداعى ما مر من وجوه و أجساد و بناء)(7(.
نفس الوقائع تقريبا حصلت مع حبيبها المخادع غانم، لكن في الجناح الغربي للعالم العربي، هذه المرة، و بالدار البيضاء تحديدا، في سبعينيات القرن الماضي، أو ما أصبح يعرف اختصارا في الأدبيات السياسية المغربية بسنوات الجمر و الرصاص، يكفي أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، واقعة يوم الأحد القائض من شهر غشت، و رغبته الطبيعية الاستحمام في شاطيء جميل هاديء مهجور قرب بناية شامخة بالمحمدية، و كيف تحولت بطريق كافكاوية عجيبة لكابوس مدمر مرعب قضى على إثره غانم عقوبة حبسية نافذة لمدة سنتين ، مع ظروف التخفيف، بتهمة المس بالمقدسات ، يقول: ( يوم أحد مدهش ، يوم استثنائي، بلا نظير، ستتلوه أيام ، ستعقبه أسابيع، يختلف عن كل ما عشته قبلها، و لن تشبه ما سأعيشه بعدها، يوم أحد غريب فعلا، غامض و قاس، حتى و لو لم يمس جسدي بسوء، صار بعيدا في الزمن، و أكاد أراه دوما عن كثب،،،، قبل ذلك اليوم كنت أحسب أن الغرابة خيال، أو تأليف قصصي، قرأت منه الكثير، و لحظة ينشب في أظافره أستطيع التخلص منه، بالتخلي عن الكتاب، و نسيان القصة، لكن كيف أنسى قصة أنا بطلها، و أتحمل تبعاتها و وزر غرابتها)(8(.
و بذلك يتضح ، بشكل جلي جدا، أنه مهما اختلفت ظروف و حيثيات هجرة كل شخصية من الشخصيات الروائية، و مهما تباعدت أوطانها جغرافيا( لبنان/المغرب)، فإنها تلتقي جميعها في النهاية عند مأساة واحدة، لا فرق بين نتائجها التهجيرية القسرية على المغربي أو اللبناني، لتتأكد بذلك مقولة الشاعر العربي: ( كلنا في الهم شرق(.
و لعل هذا ما يفسر سر استعانة الكاتب بشخصية نسائية لبنانية في رواية مغربية، رغبة منه في توسيع دائرة وصف المأساة العربية المشتركة، لتشمل كل البلاد العربية من المحيط إلى الخليج دون استثناء، خلافا لما اعتدناه في بعض الروايات الأخرى التي تحصر نطاق اهتمامها في قضايا وطنية ضيقة، و كأنها قضايا خاصة ، ينفرد بها قطر عربي دون آخر، و هو ما أعطى هذه الرواية بعدا عربيا أوسع وأشمل ، أخرجها من شرنقة الهموم المحلية المألوفة المكرورة، و جعلها تلتقط مشاهد مأساوية متطابقة تقريبا، رغم تباعد سياقاتها التاريخية و الجغرافية، لتصهرها في بوثقة واحدة ، تشهد على بشاعة واقعنا القومي المشترك، و تخلفه لدرجة استحال معها مثلا في القطرين معا ( لبنان و المغرب) و لأسباب سياسية تافهة ، القيام بشعيرة الإسراع بدفن الميت إكراما له ، كما هو مطلوب ، تقول هاء في هذا الصدد: ( ،، ماتت ستي، و لم تكن غير قليل من العظام ، و بعض الجلد يكسوها، رحلت عن هذا العالم، دون أن نستطيع تلبية الشيء الوحيد الذي ألحت عليه: طلبت منا واحدا واحدا، و بهمس ووهن، أن ننقلها للجلوس ساعة زمان في البلكونة، فهي تريد أن تشم الهواء ، و ترى السماء، ربما للمرة الأخيرة، و عجزنا أن نفهمها بأن فتح الشبابيك مخاطرة ، تعادل بالضبط ما ذهبت إليه، لم يكن الوقت للنوم، و إنما لتدبر عملية الدفن ، التي بدت لنا شاقة فوق كل تقدير،تحولت الطرقات المؤدية إلى شارع غاندي إلى ممرات خطيرة، و المتاريس حوله تكاثرت، و المقبرة الوحيدة الممكنة تقع وراء الطريق العام، بعد المتحف، و هناك جهنم، بعد أن تعلمنا إطلاق النار على سيارات الإسعاف أيضا، جميع لوازمها جاهزة، و لم نكن في حاجة إلى ثياب و لا طقس الحداد، لأننا نعيش حدادا دائما ، إلا القبر، قالت أمي : بأن الله يحب أبي إذ دعاه إليه قبل أن يصبح الدفن مستحيلا، أغلقنا على الجثمان في غرفتها يومين، و أطلقنا البخور، و في اليوم الثالث، و خشية أن يستفحل الأمر، جند أخي بعض رفاقه، وقرروا أن يخرجوا النعش، و أن يدفنوها بأي ثمن، فهذا حرام، لا أذكر كيف تدبروا شاحنة متوسطة الحجم، و انطلقوا بها أيديهم على الكلاشينكوف، و تابعناهم أمي وأنا،،، و نحن نذرف الدمع بصمت، و لا يخطر ببالنا أي عزاء)(9(.
و ما دام الشيء بالشيء يذكر، فقد ذكرت هذه الواقعة حبيبها غانم بواقعة مماثلة وقعت له شخصيا في سياق تاريخي مغربي مغاير، أثناء موت والده في سنوات الستينيات، يقول:( لا أعرف إن كان أبي سيء الحظ، أم منذورا بما حصل عند وفاته، نحن أيضا حرنا كيف ندفنه، و حالة الطوارئ معلنة في الدار البيضاء، بسبب المظاهرات التي حدثت بسبب غلاء الأسعار،،(مارس 1965)، في اليوم الذي مات فيه أبي ، انفجرت الدار البيضاء، منذ الصباح الباكر، فحلقت طائرات الهلكوبتر، وتدافعت مسيرات في الدار البيضاء، و هب العساكر، و ديننا يحث على التعجيل بالدفن، و لا سبيل إلى الدفن، فأبقينا الجثمان ليلة، و نحن نتسابق في كل الاتجاهات ، بين إعداد الأوراق الإدارية، و تدبير طريق سالك لموكب الجنازة، كان الموتى و القتلى جميعا محجوزين في يوم واحد بين البيوت و الخلاء، معلومين و مفقودين بلا قبور)(10(.
و لتزداد صورة واقعنا القومي قتامة و بشاعة، كان لابد طبعا من مقارنتها ، بما يحدث في الضفة الشمالية الأخرى ممثلة في فرنسا ، و باريس تحديدا، في مناسبات جنائزية مشابهة، من احتفاء زائد ، يظهر تقدير و احترام الفرنسيين خصوصا، والأوروبيين عموما، لرموزهم في الممات كما في الحياة، و ما المراسيم الاحتفالية الضخمة المصاحبة لجنازة الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر، سوى دليل قاطع على ذلك، يقول غانم في هذا الصدد: ( لم ينفضوا أيديهم قبل قليل من طقس هائل للموت ، حين اختلطوا مع الآلاف في جنازة الفيلسوف الوجودي ، و اختنقت أزقة وشوارع، في المونبرناس، حتى المقبرة، فدفن سارتر، لابد أن يتحول إلى تظاهرة مثل وجوده بالضبط، موت رهيب موزون، و له إيقاع في الوجوه و الخطوات، أما الصمت الذي لفه ، فليس له نظير، من شارع RASPAIL و إلى نهاية ساحة EDGAR QUINET، و هو على وجه التقدير أزيد من نصف كيلومتر، تقدمت الهامات منكسرة بين الحزن و مهابة المقام، الشباب الذين أحبوا سارتر و حفوا به سنوات بين جامعة السوربون و مرابض سان جرمان، كبحوا جماحهم، أو هي ثورتهم المصطخبة هدأت فحضروا مهذبين و أنيقين)، و يضيف معلقا : ( سرت معهم ، و بكيت في سري آسفا على مفكرينا و كتابنا الذين يموتون في التجاهل، و لا تقام لهم جنازات الراقصات و الجنرالات)(11(.
لتزداد بذلك الهوة الكبيرة القائمة بين الشرق و الغرب، بين الجنوب و الشمال ، وضوحا و رسوخا، و لتصبح اللحظة الحكائية الراهنة الجامعة بين الشخصيات الروائية ، المغربية و اللبنانية، في فضاء باريس ، فرصة ثمينة لفضح حقيقة بشاعة خلفيات هذا النزوح الاضطراري ، بحثا عن الحرية و الحب و العيش الكريم ، وسببا موضوعيا مباشرا في ما رافقه من خداع متبادل بين الأصدقاء و الصديقات، كل ذلك عن طريق استرجاعات كثيرة، بعيدة و قريبة، متشابهة و مختلفة، فجر معها السرد المتن الحكائي لشظايا صغيرة موزعة على أزمنة و أمكنة و لغات مختلفة، تلتقي جميعها، في شكل فسيفسائي مرئاوي بديع ، لتقدم للقارئ صورة شاملة ومتكاملة عن حقيقة واقع الإنسان العربي عامة، من الخليج إلى المحيط، في مختلف تمظهراته و تجلياته ، تماما كما أشار لذلك بحق مؤلف الرواية في الصفحة الأخيرة للغلاف قائلا : ( من المشرق إلى المغرب، و من بلاد العرب إلى ديار الغرب، وباريس تحديدا، ترحل هذه الرواية صانعة عالما تتعانق فيه المصائرو تفترق، وتتعدد الفضاءات لتتوحد في جغرافية سياسية و ثقافية و وجودية مركبة، هي عندي رواية البحث المتولع عن مرتكز للذات ، و عن أفق للكرامة الإنسانية، تقوده شخصيات تتقلب فوق جمر الهوى و النضال و الغربة و خداع الحياة، فسراب المثل بين النهوض و السقوط (+) .)
لهذه الأسباب و غيرها كثير ، أظن أن هذه الرواية ، رغم ما طلها من حيف نقدي غير مبرر: ( تمثل تطورا آخر في مسار أعمال المديني، في توليفها بين نسغ الواقع و رفيف الخيال ، لصوغ معادلة التخييل المركب، و نسجها على نول التعيين والإيحاء معا، نشدانا لجمال الكتابة و متعة القراءة، و بخصائصها جميعا، هي مغربية و عربية، و ذات طموح إنساني أوسع(+).)
بيان الإحالات و الهوامش:
+) نص العرض الذي شاركت به في ندوة ( بيروت في الرواية ، الرواية في بيروت)، المنظم من قبل الجامعة اللبنانية ، الفرع الأول ، في الفترة الواقعة بين 10و12 مارس 2010، بالعاصمة اللبنانية بيروت.
+) أحمد المديني : المخدوعون ، رواية، منشورات المديني ، الرباط ، 2005.
+) نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
القاهرة تبوح بأسرارها ، لعبد الكريم غلاب.
شرقية في باريس. لعبد الكريم غلاب.
مثل صيف لن يتكرر، لمحمد برادة.
رفقة السلاح و القمر، لمبارك ربيع.
المرأة و الوردة، لمحمد زفزاف.
المصري، لمحمد أنقار.
غربية الحسين، لأحمد توفيق.
الغربة و اليتيم ، لعبد الله العروي.
+) تراجع بهذا الخصوص دراستنا النشورة بمجلة الآداب البيروتية ، عدد : 5/6 لشهري ماي و يونيو ، سنة 2003، بعنوان : ( المحطات الرئيسية في الرواية المغربية).
+) يراجع بهذا الخصوص ما قاله أمبرتو إيكو في مقدمة كتابه القيم : القارئ في الحكاية).
+) لعل هذا ما يفسر القول المأثور: ( مصر تكتب، و لبنان تنشرن و المغرب يقرأ).
+) للإشارة فقط ، صدر للأستاذ أحمد المديني قبل هذا العمل و بعده الروايات التالية:
زمن بين الولادة و الحلم، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1976.
وردة للوقت المغربي، دار الكلمة، بيروت، 1983.
الجنازة، دار قرطبة، الدار البيضاء، 1987.
حكاية وهم ، دار الآداب، بيروت، 1993.
طريق السحاب، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1994.
مدينة براقش ، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، 1998.
العجب العجاب، منشورات رابطة أدباء المغرب، الرباط، 1999.
الهباء المنثور، دار نشر المعرفة، الرباط، 2001.
فاس لو عادت إليه، دار المعارف الجديدة، الرباط، 2003.
رجال ظهر المهراز
و هموم بطة
+) يلاحظ أن المديني أصدر لحد الساعة ، و على امتداد ثلاثة عقود، ما يفوق ثلاثين عملا، موزعا بين الرواية ، القصة، الدراسة، الشعر، و الترجمة.
1) أحمد المديني : رواية مذكورة،2005، ص: 5.
2) أحمد المديني: رواية مذكورة، 2005، ص:257.
3) أحمد المديني: رواية مذكورة، 2005، ص:68.
4) أحمد المديني: رواية مذكورة، 2005، ص:66.
+) هكذا كان يلقبه أصدقاؤه في باريس.
5)أحمد المديني: رواية مذكورة، 2005، ص:247.
+)كل شخصية روائية حكاية، كما قال تودوروف في إحدى دراساته عن ألف ليلة و ليلة.
6)أحمد المديني: رواية مذكورة، 2005،ص:50.
7)أحمد المديني : رواية مذكورة، 2005، ص:51.
8)أحمد المديني: رواية مذكورة، 2005،ص:90.
9)أحمد المديني: رواية مذكورة،2005،ص:113/114.
10) أحمد المديني: رواية مذكورة، 2005، ص:116.
11) أحمد المديني: رواية مذكورة، 2005،ص:114.
+) أحمد المديني: رواية مذكورة، 2005، الصفحة الرابعة للغلاف.